أرشيف الفتاوى
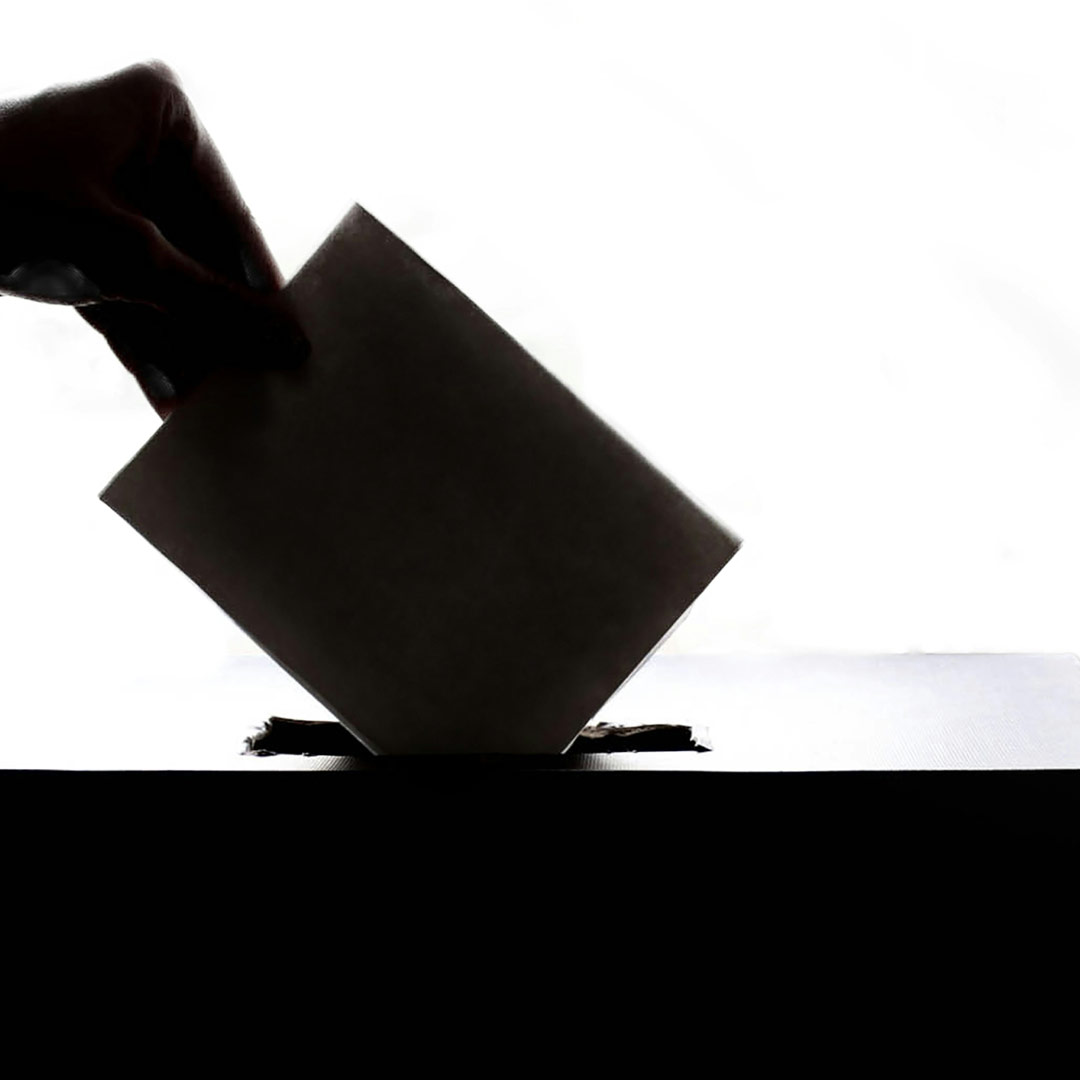

شرع جهاد القتال في سبيل الله لأجل غايات نبيلة وأهداف كريمة عزيزة وليس لأجل القتال للقتال، أو القتال لاحتلال دول أخرى بهدف الاستيلاء على خيراتها واسترقاق رجالها وسبي نسائها، وقد وقعت الجماعات المتطرِّفة في أخطاء جسيمة في فهم الجهاد وما جاء فيه من نصوص الشَّريعة، فلوَّوا أعناقها، وفرَّقوا بين ما حقه أن يجمع، وجعلوا لأنفسهم جهادًا مستقلًا عن فهم علماء أهل السنة، فهبوا لا ليقاتلوا المعتدي على الأرض كما هي شعاراتهم ودعاويهم، بل كان القتال للمسلمين الموحدين، فهو جهاد خاص بدين هؤلاء الخوارج لا الجهاد الذي شرعه الله ورسوله.
لقد صار للجهاد عند هؤلاء نسق خاص، وتطبيق خاصٌّ بهم، لا يتحقق إلا به، نسق يتخلص فيه المسلم من آدميته وأخلاقه الإسلامية، ليفسد في الأرض بعد إصلاحها، ليحرق ويقطع ويلبي شهواته الحيوانية متسترًا بغطاء الشرع وهو منه براء، وصدق الله إذ يقول: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَام ﮀ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَاد) [البقرة:205].
وقد نبأنا رسول الله ﷺ بأخبارهم وحذرنا من أفعالهم، فعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: بعث علي رضي الله عنه، إلى النبي ﷺ بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، فغضبت قريش، والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: «إنما أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد، فقال: «من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني» فسأله رجل قتله، - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه، فلما ولى قال: «إن من ضئضئ هذا، أو: في عقب هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»([1]).
وفي هذا المبحث ننظر إلى الجهاد نظرة تتوافق ونظرة أهل العلم الكرام، وتتَّفق مع مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، نظرة تبيِّن وجه الانحراف عند الجماعات الجهاديَّة والحركيَّة خوارج العصر، وكيف أنَّهم جعلوا من عبادة الجهاد ما صدُّوا به النَّاس عن طريق الله وعن الإسلام.
لغة: يأتي الجهاد في اللغة مشتقًا من (جهد) وهي دالة على المشقة وبذل الوسع. قال الفيُّوميُّ في المصباح المنير: «جاهد في سبيل الله جهادًا واجتهد في الأمر بذل وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته»([2]). وقال الرَّاغب الأصفهانيُّ: «الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدوِّ، والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدوِّ الظَّاهر ومجاهدة الشَّيطان ومجاهدة النَّفس»([3]). اهـ
وما ذكره الرَّاغب الأصفهانيُّ من جهاد غير العدوِّ؛ أي الشَّيطان والنَّفس، هو ما جاء به الحديث النَّبويِّ في الكلام عن (الجهاد الأصغر) و(الجهاد الأكبر)، ففيه: «قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه»([4]).
وأما في الشَّرع: وهو ما تواردت عليه كتب الفقهاء من اختصاص كلمة الجهاد بـ(القتاليِّ) وعرَّفوا الجهاد فيه بـ(القتال)، فكما عرَّفه ابن الكمال: «بأنَّه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرةً أو معاونةً بمالٍ، أو رأيٍ أو تكثير سوادٍ أو غير ذلك»([5]) قال ابن عابدين: «كمداواة الجرحى وتهيئة المطاعم والمشارب»([6]) وهذا المعنى للجهاد هو الَّذي ذكروا له من الشُّروط والأحكام ما سيأتي بعضه في موضعه، ويأتي ذكر الجهاد في كتب الفقه بأبوابٍ إمَّا مترجمة باسم (الجهاد) أو باسم (السِّير) أو باسم (المغازي) لأنَّ الأحكام الَّتي تذكر فيه متلقاة من سير الرَّسول ﷺ وغزواته([7]).
الفرق بين مصطلح الجهاد ومصطلح الحرب:
والجدير بالذكر هنا أن نبين اختلاف مفهوم الجهاد عن مفهوم الحرب في فقه القانون الدولي الحديث؛ حيث ينظر فقهاء القانون الدولي للحرب على أنها وسيلة لغاية السياسة للحصول على بعض المكاسب المادية أو السياسية دون مراعاة للقيم أو المبادئ الأخلاقية او الروحية. وقد عرَّف فقهاء القانون الدولي الحرب بأنها: حالة قانونية تتولد عند نشوب كفاح مسلح بين القوات المسلحة كدولتين أو أكثر مع توفر نية إنهاء العلاقات السلمية بين إحدى هذه الدول، أو لديها جميعًا([8]). فالحرب عبارة عن صراع دموي بين إرادتين، مراد كل منهما التفوق على الأخرى، وتحطيم مقاومتها، وحملها على التسليم لها بما تريده من شروط معينة يفرضها الطرف القوي، وينزل عليها الطرف الضعيف المنهزم، وصورة هذا الصراع هي العنف أبدًا، وشكله القتال بين قوتين متخاصمتين، وبذلك تكون الحرب هي أقصى صورة للتنافس البشري، وهي أشبه ما تكون بعملية التطور الذي يأخذ دوره بين الكائنات الحية في صورة صراع دائم، ينتهي ببقاء الأقوى أو الأصلح، ثم يتجدد بظهور عناصر أقوى وأصلح تقضي على ما قبلها.
أما علماءُ الفقه الإسلامي فإنهم لم يعبروا عن مفهوم الجهاد بالحرب اتباعًا للقرآن الكريم، ولما تحمله هذه الكلمة من معنى الصراع والتناحر ومحاولة الاستيلاء على ممتلكات الغير بغير وجه حق، إنما عبروا بلفظ الجهاد وهو لفظ شرعيٌّ، ولم يكن الجهاد يومًا مقصورًا على القتال وحده، ولم تكن كذلك كلمة الجهاد في عرف المسلمين ولا مفهوم أهل اللغة مرادفة لمفهوم الحرب، بمعنى إرغام الناس على اعتناق دين معين أو الاستيلاء على ممتلكاتهم، كما فهم ذلك خطأً بعض علماء الغرب وشعوبهم. ونظرًا لتمايز مفهوم الجهاد في المنظور الإسلامي عن مفهوم الحرب في منظور القانون الدولي الحديث، تمايز تبعًا لذلك مفهوم العهد أو المعاهدة بين المنظور الإسلامي والقانون الدولي. ويوضح الدكتور خالد رمزي الفرق بين المعاهدات في الإسلام والمعاهدات الحديثة بقوله: يفهم من قوله تعالى: (فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين) [التوبة:4].
عدم قتال أهل العهد ما داموا في عهدهم، وحتى إن نقضُوا عهدهم، فإنَّ الأصل ألا يقاتلوا إلا بعد إعلامهم أنَّ العهد معهم تم نقضُهُ من طرفهم، ولا يمكن تصور قتالهم غدرًا من قبل المسلمين، لأنَّ النُّصوص الشَّرعية تعتبر الغدر خُلقًا ذميمًا ينبغي البعد عنه.
بينما النَّاظر في أحوال الحروب الحديثة، يرى أنها لا تُراعي حرمة المعاهدات، إنما تعتبرها حبرًا على ورق، ومقياس الالتزام بهذه المعاهدات في أيامنا هذه مدى ما تحققه من مصالح، بعكس النظرة الإسلامية لمسألة الالتزام بالمعاهدات، فإنَّها غير مرتبطة بالمصالح، وإنما بمسألة الوفاء بالعقود، وهي مسألة تتعلق بأصول العقيدة مما يعطي المسألة بُعدها الدِّينيِّ. ا.هـ([9]).
ومن خلال تحليل هذه التعاريف يتبين لنا الآتي:
أنَّ الجهاد غايتُهُ إعلاء كلمة الله تعالى ويكون ابتداء بالطُّرق السِّلمية، وذلك بالدَّعوة الصحيحة إلى دين الله عزَّ وجلَّ، بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو جهاد الحجة. أن الجهاد كما يكون بالحجة، قد يلجأ فيه إلى القتال، وإن وقع القتال فإنه يكون بين المسلمين وأعدائهم من الكافرين -المعتدين المحاربين- ولا يمكن تصور وقوعه بين المسلمين أنفسهم، وحين يلجأ ضرورة للقتال فإن الغرض منه يكون واضحًا، وهو حماية دولة الإسلام ورعايها والمحافظة على سير الدعوة الإسلامية دون صعوبات، ولا يمكن أن يكون غرض الجهاد التسلط على رقاب الناس وسيادة الأمم، وهذا بخلاف ما نصَّ عليه فقهاء القانون الدولي في تعريف الحرب فإنَّهم لم يراعُوا في تعاريفهم سوى الاستيلاء والسَّيطرة على ممتلكات الغير، وتدمير مقاومة الخصم، حتى ولو كانوا جميعًا من نفس الدِّين.
إنَّ فهم قضية الجهاد والتعامل معه التعامل الصَّحيح يقتضي أن يُنظر إلى تاريخ مشروعيَّته، وكيف كانت مراحله المختلفة الَّتي شرع من خلالها حتى وصل إلى صورة الجهاد الموجود في كتب الفقه؛ وهو الجهاد الَّذي يُحفظ به الإسلام؛ ويردُّ به العدوان، وتحفظ به مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، وهذه الأهميَّة يدلُّنا علىها استفاضة كتب الفقه في ذكر مراحلها التاريخيَّة في استهلال الكلام على الجهاد في بابه، ابتداءً من البعثة أحيانًا؛ وابتداءً من دعوة الأنبياء على العموم أحيانًا أخرى.
والجهاد ليس حكمًا تشريعيًّا خاصًا بالأمَّة الإسلاميَّة فقط بل هو من الأحكام الَّتي جعلها الله سبحانه وتعالى لكلِّ أمَّةٍ، دلَّنا على هذا آيات القرآن في قصَّة طالوت وجالوت، وما كان بين سليمان وملكة سبأ، وما كان من قصَّة ذي القرنين.
أمَّا الجهاد في الإسلام فكان بالأصالة مشروعًا في فترة دعوة النَّبيِّ ﷺ قومه بمكة، إلَّا أنَّ الفارق بين هذا الجهاد وجهاد ما بعد الهجرة النبويَّة؛ هو أنَّ جهاد مكة كان ممنوعًا فيه القتال، قال الإمام النَّوويُّ «وكان القتال ممنوعًا منه في أول الإسلام وأمروا بالصَّبر على أذى الكفَّار، فلمَّا هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة، وجبت الهجرة على من قدر، فلمَّا فتحت مكة، ارتفعت الهجرة منها إلى المدينة، ونفي وجوب الهجرة من دار الحرب على ما سنذكره- إن شاء الله تعالى- ثمَّ أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفَّار بقتال »([10]).
وأمَّا الجهاد الَّذي كان بمكَّة فقد أشارت سورة الفرقان- وهي مكِّية النُّزول- في قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾[الفرقان: 52] وفي سورة النَّحل ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيم ﴾[النحل: 110]، وهي مكِّية كلها عند جمهور علماء التفسير ومنهم ابن الزُّبير والحسن البصريِّ وعكرمة وعطاء وجابر، وقال ابن عباس هي مكِّية إلا ثلاث آيات منها وهي الآيات [95 و96 و97] بدءًا من قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً...﴾ إلى قوله عز وجل: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾[النحل: 97] أي فليس منها الآية الَّتي نحن بصددها بل هي مكِّية على كلا القولين.
وخالفت قلة فذهبت إلى أن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ...﴾ الآية ممَّا نزل بالمدينة([11]). فهو «مواجهة رسول الله ﷺ المشركين ومن ورائه أصحابه بدعوته إلى الحقِّ وتفنيد ما كانوا يعكفون عليه من تقاليد الآباء والأجداد وإنَّ من أهمِّ أنواعه ثباته وثباتهم معه على الصَّدع بكلمة الحق مهما جرَّ ذلك عليهم من أنواع الشِّدة والإيذاء وإن من أهمِّ أنواعه مضيَّهم في التَّبصير بكتاب الله والتَّعريف به والتَّنبيه إلى إخباراته وأحكامه دون أيِّ مبالاةٍ بالأخطار الَّتي كانت تحدق من جرَّاء ذلك بهم»([12]).
ثمَّ لمَّا هاجر النَّبيُّ ﷺ إلى المدينة شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد «القتاليَّ» ولم يكن هكذا دفعةً واحدةً؛ بل كان على مراحل كل مرحلة لها أسبابها تبيِّنه آيات الجهاد في القرآن الكريم.
قال ابن عابدين: «ثمَّ اعلم أنَّ الأمر بالقتال نزل مرتبًا فقد كان ﷺ مأمورًا أوَّلًا بالتَّبليغ، والإعراض: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِين ﴾[الحجر: 94] ثمَّ بالمجادلة بالأحسن ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾[النحل: 125] الآية- ثمَّ أذن لهم بالقتال- ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾[الحج: 39] الآية، ثمَّ أمروا بالقتال إن قاتلوهم- ﴿فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾[البقرة: 191] ثمَّ أمروا به بشرط انسلاخ الأشهر الحرم ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ ﴾[التوبة: 5] ثمَّ أمروا به مطلقًا ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾»([13]).
فابتدأ الله سبحانه وتعالى أمر الجهاد (القتاليِّ) بآية: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾[الحج: 39] الآية، قال قتادة: «وهي أوَّل آية نزلت في القتال، فأذن لهم أن يقاتلوا»([14])، ثمَّ بيَّن الله سبحانه وتعالى سبب هذا الإذن بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ﴾[الحج: 40].
قال الطَّبريُّ في تفسيره: «أذن الله للمؤمنين الَّذين يقاتلون المشركين في سبيله بأنَّ المشركين ظلموهم بقتالهم»([15]).
وقد استمر أمر القتال في عهد النَّبيِّ ﷺ قائمًا على رد العدوان من المشركين، حتَّى نزلت آية التوبة: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾[التوبة: 5].
قال البدر العيني: «هذه الآية الكريمة في سورة براءة، وأوَّلها قوله عز وجل ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم﴾[التوبة: 5] نزلت في مشركي مكَّة وغيرهم من العرب. وذلك أنَّهم عاهدوا المسلمين ثمَّ نكثوا إلَّا ناسًا منهم، وهم بنو ضمرة وبنو كنانة، فنبذوا العهد إلى النَّاكثين، وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين إن شاؤا لا يتعرض لهم، وهي الأشهر الحرم، وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها، فإذا انسلخت قاتلوهم»([16]).
وقال الحلبيُّ في السِّيرة: «ثمَّ لما رمتهم العرب قاطبة عن قوس وتعرَّضوا لقتالهم من كلِّ جانب كانوا لا يبيتون إلَّا في السِّلاح ولا يصبحون إلَّا فيه ويقولون ترى نعيش حتَّى نبيت مطمئنِّين لا نخاف إلَّا الله عز وجل انزل الله عز وجل: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾[النور: 55] ثم أذن في القتال أي أبيح الابتداء به حتَّى لمن لم يقاتل أي لكن في غير الأشهر الحرم أي الَّتي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أي بقوله ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾[التوبة: 5] الآية ثم أمر به وجوبًا أي بعد فتح مكة في السَّنة الثَّانية مطلقًا أي من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله ﴿ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً ﴾[التوبة: 36] أي جميعًا في أيِّ زمن»([17]).
فالمستقر من هذه الآيات أنَّ السَّبب التَّشريعيَّ الأوَّل في الجهاد هو دفع الظُّلم الواقع على المسلمين بما كان من تعذيب المشركين للمؤمنين وإيذائهم لهم وإخراجهم من أوطانهم ومصادرة أموالهم حتَّى جاء أمر الله بالهجرة، فشرع الله الجهاد حمايةً للإسلام وللمؤمنين ودولتهم، وردًا للظُّلم والعدوان الواقع عليهم، كان في بداية الأمر دفعًا للقتال بمثله: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ ﴾ [البقرة: 190] و﴿فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ إلى آخر هذه الآيات، ثمَّ لما ظهر العناد المستمر من العرب، بل وعدم احترامهم للعهد، مع إظهار الله سبحانه وتعالى الآيات والعلامات الدَّالة لكلِّ مريد للحقِّ؛ أمر الله سبحانه وتعالى نبيَّه بتعميم أمر القتال في العرب، وهذا لأنَّ معنى القتال وهو العدوان ما زال فيهم لم يزل ولم يبق منهم إلَّا عناد وجهل، وهذا المعنى هو الَّذي يطلق عليه (الحرابة)، ومع هذا أعطى المولى سبحانه وتعالى لمن أراد معرفة الحقَّ أن يأخذ الأمان ليسمع آيات الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُون ﴾[التوبة: 6].
ولأجل ما سبق بيانه كان المعنى في الجهاد هو (الحرابة) بمعنى الاعتداء من العدوِّ، وإعلانه الحرب.
مكانة الجهاد من أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة ومقاصدها
النَّاظر للجهاد– كما وضحناه- يجد أنَّ معنى الحرابة واضحًا فيه؛ فالجهاد باعتباره فردًا من أفراد قسم المعاملات في الفقه الإسلامي يجد أنه ليس مشروعًا لذاته، ولا لأجل اختلاف الدين ولا لحمل الناس على الدخول في الإسلام، بل هو مشروع لأجل حفظ مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة؛ جميعها!
قال العلائيُّ في قواعد المذهب: «والضَّرب الثَّاني- أي من أقسام المعاملات- هو أقسام المضارِّ الخمس الضَّروريَّة وهي مضرَّة النُّفوس والأديان والأموال والأنساب والعقول فيدخل في الأوَّل أحكام القصاص في النَّفس والطَّرف وأحكام الدِّية فيهما وما يتعلَّق بذلك ويدخل في الثَّاني أحكام الكفر والإسلام وما به يصير الشَّخص مسلمًا وكافرًا وأحكام الرِّدَّة ومن يقرُّ على دينه من الكفَّار بالجزية وما يتعلق بها من الأحكام ويتَّصل بذلك عقد الهدنة أيضًا»([18]).
وقال البيجوريُّ في حاشيته تعليقًا على قول صاحب الجوهرة:
|
وحفظ دين ثمَّ نفس مال نسب |
ومثلها عقل وعرض قد وجب |
«قوله: «دين» أي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام والمراد بحفظه صيانته عن الكفر وانتهاك حرمة المحرمات ووجوب الواجبات فانتهاك حرمة المحرَّمات أن يفعل المحرَّمات غير مبالٍ بحرمتها، وانتهاك وجوب الواجبات: أن يترك الواجبات غير مبالٍ بوجوبها، ولحفظ الدِّين شرع قتال الكفَّار الحربيين وغيرهم كالمرتدِّين»([19]).
وقال ابن عابدين في حاشيته في مقصود الجهاد: «إخلاء الأرض من الفساد»([20]).
فمشروعيَّة الجهاد آتية بسبب ما سمي بـ(الحراب). قال الكاساني: «فالمبيح للدَّم على ذلك هو الكفر الباعث على الحراب»([21]) وهو الاعتداء.
و«الحراب» في اللغة من الحرب، قال في تاج العروس: «حاربه محاربةً وحرابًا، وتحاربوا واحتربوا وحاربوا بمعنى»([22]).
وهذا المعنى في الجهاد وهو الحرابة هو قول جماهير العلماء .
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: «ولا يقتلوا امرأةً ولا صبيًا ولا شيخًا فانيًا ولا مقعدًا ولا أعمى؛ لأنَّ المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقَّق منهم »([23]).
وقال الكاسانيُّ في البدائع: «لا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي، ولا شيخ فانٍ، ولا مقعد ولا يابس الشِّق، ولا أعمى، ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف، ولا مقطوع اليد اليمنى، ولا معتوه، ولا راهب في صومعة، ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس، وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم الباب، أمَّا المرأة والصبي، فلقول النَّبيِّ ﷺ «لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا»([24]) وروي أنه- عليه الصلاة والسلام- رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال- عليه الصلاة والسلام-: «هاه ما أراها قاتلت، فلم قتلت؟ ونهى عن قتل النساء والصبيان»([25]) ولأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل القتال، فلا يقتلون، ولو قاتل واحد منهم قتل، وكذا لو حرَّض على القتال، أو دلَّ على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعًا، وإن كان امرأة أو صغيرًا؛ لوجود القتال من حيث المعنى.
وقد روي أنَّ ربيعة بن رفيع السلميِّ- رضي الله عنه- أدرك دريد بن الصِّمَّة يوم حنين، فقتله وهو شيخ كبير كالقفة، لا ينفع إلا برأيه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ولم ينكر عليه([26])»([27]).
وقال ابن قدامة في المغني: «ولا تقتل امرأة، ولا شيخ فانٍ. وبذلك قال ومالك، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن أبي بكر الصدِّيق، ومجاهد، وروي عن ابن عبَّاس في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْتَدُواْ﴾ [البقرة: 190]. يقول: لا تقتلوا النِّساء والصِّبيان والشَّيخ الكبير»([28]).
وقال الدَّردير في الشَّرح الكبير: «المرأة فلا تقتل إلا في مقاتلتها فيجوز قتلها إن قتلت أحدًا أو قاتلت بسلاح كالرِّجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرميِّ حجر فلا تقتل ولو حال القتال و إلَّا الصبي المطيق للقتال فلا يجوز قتله، ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل.
و إلَّا المعتوه أي ضعيف العقل فالمجنون أولى كشيخ فانٍ لا قدرة له على القتال وزمن بكسر الميم أي عاجز وأعمى عطف خاص على عام وراهب منعزل عن أهل دينه بدير أو صومعة لأنَّهم صاروا كالنِّساء حال كونهم بلا رأي وتدبير و إذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفَّار الكفاية فقط أي ما يكفيهم حياتهم على العادة، وقدم مالهم على مال غيرهم، ويؤخذ ما يزيد على الكفاية، فإن لم يكن لهم ولا للكفَّار مال وجب على المسلمين مواساتهم إن أمكن»([29]).
- الأدلة على أن الحرابة والاعتداء هي مناط تشريع القتال وليس مجرد الكفر:
واستدلالات الجمهور في ذلك كثيرة، قال الشَّيخ عبد الوَّهَّاب خلَّاف: «واحتجُّوا على هذا ببراهين:
أوَّلًا: أنَّ آيات القتال في القرآن الكريم جاءت في كثير من السُّور المكِّية والمدنيَّة مبيِّنة السبب الَّذي من أجله أذن في القتال وهو يرجع إلى الكفَّار على عهد الرَّسول ﷺ سواء أكانوا من المشركين أم من أهل الكتاب أمعنوا في إيذاء المسلمين بألوان العذاب فتنة لهم وابتلاء حتَّى يرجعوا من أسلم عن دينه ويثبطوا من عزيمة من يريد الدُّخول في الإسلام، وغايتهم من هذه الفتن والمحن أن يخمدوا الدعوة ويسدُّوا الطَّريق في وجه الدُّعاة، فالله سبحانه أوجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء المعتدين دفعًا لاعتدائهم وإزالةً لعقباتهم حتَّى لا تكون فتنة ولا محنة، ولا يحول حائل بين المدعوِّين وإجابة الدَّعوة وإذ ذاك يكون الدِّين كلُّه لله»([30]).
وهذه الآيات:
قوله تعالى:﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين ﯽ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينﭮ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم ﭵ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِين ﴾ [البقرة: 191- 193].
قال الطَّبريُّ: «عن يحيى بن يحيى الغسَّاني، قال: كتبتُ إلى عمر بن عبد العزيز أسألهُ عن قوله: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين ﴾ قال: فكتب إليَّ: إنَّ ذلك في النِّساء والذريَّة ومن لم يَنصِبْ لك الحرَب منهم»([31]).
وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾[النساء: 75].
وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير ﴾[الأنفال: 39].
وقوله تعالى: ﴿ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِين ﴾[التوبة: 13].
وقوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير ﭜ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز﴾[الحج: 39، 40].
وقوله تعالى: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ﮏ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾[الممتحنة: 8، 9].
قال الدُّكتور البوطيُّ رحمه الله: «فهذه الآيات صريحة الدَّلالة على أنَّ علَّة الجهاد القتاليَّ للكافرين هي الحرابة، وقد تفرَّق نزولها في آمادٍ مختلفة من العهد المدنيِّ، وفيها ما قد نزل قبل وفاة رسول الله ﷺ بأشهرٍ، ومن ثمَّ فيه الحجَّة لمذهب الجمهور»([32]).
- الأدلة من السنة على أن الكفر ليس مبيحا للقتال:
عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع رسول الله ﷺ فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها النَّاس، فأفرجوا له، فقال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل، ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد، فقل له إن رسول الله يأمرك بقول: لا تقتلنَّ ذريَّة ولا عسيفًا»([33]).
وقول النَّبيِّ ﷺ: انطلقوا باسم الله، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا ولا امرأةً ولا تغلوا، وضمُّوا غنائمكم وأصلحوا، وأحسنوا إنَّ الله يحبُّ المحسنين»([34]).
وفعل أبي بكر وما أوصى به أسامة وأصحابه غداة توديعه له وتسييره لجيشه وقد كان ذلك أول عملٍ قام به أبو بكرٍ فقد جاء في وصيَّته: «لا تخونوا ولا تغدروا لا تغلوا ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا طفلًا ولا شيخًا كبيرًا ولا امرأة... وإذا مررتم بقومٍ قد فرَّغوا أنفسهم في الصَّوامع فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له»([35]).
فالَّذي استدل به الجمهور من هذه الأحاديث هو النَّهي عن قتال غير المقاتلة- أي بالقوَّة- ولهذا لما مرَّ النَّبيُّ ﷺ بالقتلي ووجد امرأة مقتولة قال: «ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل»([36])، فكان إنكارًا من النَّبيِّ ﷺ لقتل مثل هذه المرأة الَّتي لا يتأتى منها نوع قتال أو اعتداء.
قال الشَّيخ عبد الوهَّاب خلَّاف: «احتجُّوا باتِّفاق جمهور المسلمين على أنَّه لا يحل قتل النِّساء والصِّبيان والرُّهبان والشَّيخ الكبير والأعمى والزَّمِن ونحوهم لأنَّهم ليسوا من المقاتلة، ولو أنَّ القتال كان للحمل على إجابة الدَّعوة وطريقًا من طرقها حتى لا يوجد مخالف في الدِّين ما ساغ استثناء هؤلاء فاستثناؤهم برهان على أنَّ القتال إنَّما هو لمن يقاتل دفعًا لعدوانه. ولو قيل إنَّهم استثنوا لأنَّهم لغيرهم تبع فهذا إن سلِّم في الصِّبيان والنِّساء لا يسلَّم في البواقي وخاصِّة في الرُّهبان.
وثالثًا: وسائل القهر والإكراه ليست من طرق الدَّعوة إلى الدِّين لأنَّ الدِّين أساسه الإيمان القلبيِّ والاعتقاد وهذا أساسٌ تكونه الحجَّة لا السَّيف، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾[البقرة: 256]، ويقول سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِين ﴾[يونس: 99]. فهذا المعنى هو مبنى أمر الجهاد، دفع اعتداء الغير عن ديار الإسلام»([37]).
ثم قال رحمه الله: «والنظر الصحيح يؤيد أنصار السِّلم القائلين بأن الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال إلا إذا أريدوا بسوء لفتنتهم عن دينهم أو صدِّهم عن دعوتهم فحينئذ يفرض عليهم الجهاد دفعًا للشر وحماية للدَّعوة وهذا بيِّن في قوله تعالى في سورة الممتحنة المدنيَّة: ﴿ لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين ﮏ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾[الممتحنة: 8، 9]، وقوله تعالى في سورة النِّساء المدنيَّة: ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا ﴾[النساء: 90]، وقوله في سورة الأنفال المدنيَّة: ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ﴾[الأنفال: 61]. وفي كثير من آي الكتاب وأصول الدِّين ما يعزز هذه الرُّوح السلميَّة ويبعُد أن يكون الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على الحرب الدَّائمة وأن يكون فرَض الجهاد وشرع القتال على أنه طريق الدعوة إلى الدِّين لأنَّ الله نفى أن يكون إكراه على الدِّين وأنكر أن يكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وكيف يتكون الإيمان بالإكراه ويصل السَّيف إلى القلوب. إن طريق الدَّعوة إلى التَّوحيد والإخلاص لله وحده هي الحجَّة لا السَّيف ولو أنَّ غير المسلمين كفُّوا عن فتنتهم وتركوهم أحرارًا في دعوتهم ما شهر المسلمون سيفًا ولا أقاموا حربًا.
وما احتج به بعضهم على خلاف ذلك من أن التي جاءت مطلقة ليس برهانًا قاطعًا على ما يقولون لأنَّه لم يوفق بين هذه الآيات المطلقة والآيات المقيدة بحمل المطلق على المقيد على معنى أن الله سبحانه أذن في القتال لقطع الفتنة وحماية الدعوة، وتارة ذكره مقرونًا بسببه وتارة ذكره مطلقًا اكتفاء بعلم السبب في آيات أخرى. ولو كان بين الآيات تعارض كانت المتأخرة ناسخة للمتقدمة فلم يذكر السبب الذي من أجله أذن في القتال آخرًا كما ذكر السبب في الأذن به أوَّلًا، وكيف تكون الآيات المقيدة منسوخة مع أن وجوب القتال لدفع العدوان مجمع عليه ولم يقل بنسخ هذا الوجوب أحد. فلا موجب لتقرير تعارض الآيات والقول بنسخ المطلق للمقيد لأنَّ هذا تمزيقٌ للآيات ويترتب عليه نسخ كثيرٍ منها، حتى قال بعض المفسرين: إن المنسوخ بآية السيف نحو مائة وعشرين آية ومن هذه الآيات كل ما يدل على أخذٍ بالعفو أو دعوةٍ بالحكمة أو جدالٍ بالحسنى أو نفيٍ للإكراه على الدِّين»([38]).
قال ابن تيميَّة: «وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدِّين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، كالنِّساء والصِّبيان والرَّاهب، والشَّيخ الكبير، والأعمى، والزَّمِن، ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلَّا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر؛ إلَّا النِّساء والصِّبيان؛ لكونهم مالًا للمسلمين. والأول هو الصَّواب؛ لأنَّ القتال هو لمن يقاتلنا، إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين ﴾ [البقرة: 190]. وفي السنن عنه ﷺ: «أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه، قد وقف عليها الناس. فقال: ما كانت هذه لتقاتل»([39]) وقال لأحدهم: «الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريَّة ولا عسيفًا»([40]). وفيها أيضا عنه ﷺ أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة». وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: 191]. أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفَّار من الشَّر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلَّا على نفسه»([41]).
وهذا المعنى هو المتَّفِق والملاءم لما صدَّرنا به هذا المبحث من إتيان أمور المعاملات– والَّتي منها الجهاد- مراعية لمقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة.
ثمَّ إنَّ العلماء يزيدون هذا المعنى إيضاحًا في بيان كيفية حصول فرض الجهاد:
قال ابن عابدين: «ولا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرًا من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية، لقتال العدو فإن قاموا به سقط عن الباقين، وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدوِّ، فعلى من وراءهم من المسلمين الأقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم، وأن يمدوهم بالسِّلاح والكراع والمال لما ذكرنا إنَّه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد، ولكن سقط الفرض عنهم لحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط اهـ.
قلت: وحاصله أن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدوِّ»([42]).
وهذا المعنى الذي ذهب إليه الجمهور، نراه عين ما قال به متأخرو الشافعيَّة.
قال ابن حجر في التحفة: «وأما بعده فللكفار الحربيين (حالان أحدهما يكونون) أي كونهم (ببلادهم) مستقرين فيها غير قاصدين شيئا (فـ) الجهاد حينئذ (فرض كفاية) إجماعًا، كما نقله القاضي عبد الوهَّاب ويحصل إمَّا بتشحين الثغور، وهي محالُّ الخوف الَّتي تلي بلادهم بمكافئين لهم، لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق، وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنُّصح للمسلمين، وإمَّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم.
وظاهر أنَّه إن أمكن بعثها في جميع نواحي بلادهم وجب، وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل، هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم؛ لأنَّه محمول عليه وصريحه الاكتفاء
بالأول وحده، ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا، ويرد بأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا، ولا يلزم عليه ما ذكر لما يأتي أنه إذا احتيج إلى قتالهم أكثر من مرة وجب، فكذا إذا اكتفينا هنا بتحصين الثغور واحتيج لقتالهم وجب»([43]).
وقال الرَّملي في النهاية: «ويحصل إما بتشحين الثغور وهي محال الخوف التي تلي بلادهم بمكافئين لهم لو قصدوها مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنُّصح للمسلمين، وإمَّا بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم؛ لأن الثغور إذا شحنت كما ذكر كان في ذلك إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا». قال عليٌّ الشبراملسي في حاشيته عليه: «ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين: إمَّا إشحان الثغور، وإمَّا دخول الإمام أو نائبه.قال محمد الرَّملي: وهو المذهب »([44]).
وقال القليوبيُّ في حاشيته على المحلي: «ويغني عن ذلك أن يشحن الإمام الثغور بمكافئين مع إحكام الحصون، أي الثغور وتقليد الأمراء ذلك أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفار بالجيوش لقتالهم فأحد هذين الأمرين كاف عن الفعل المتقدم على المعتمد»([45]). وقد اقتصر البيجوريُّ على ذلك في حاشيته على ابن قاسم([46]).
فهذا المعنى متفقٌ عليه بين الجميع؛ وهو أن الجهاد ليس مشروعًا لذاته، فلم يأت الإسلام لتلك الشَّهوة من القتل وسفك الدماء كما يبيِّن الخوارج دائمًا هذا المعنى، كلا؛ فالجهاد مشروع لغاية عظيمة ألا وهي تحقيق مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، ومن ثمَّ كان الفرض فيه في حالة عدم وجود قتال بين الأعداء تحصين الثُّغوروالذود عن البلاد، فإذا حصل الاعتداء فرد الاعتداء واجب.
وقد كانت علاقات الأمم في الماضي في غاية التَّعقد، ولم يكن ثمَّة ما يمكن أن يكون وسيلة للتواصل فيما بينها، وكان اجتماعها على الرأي صعب المنال.
يقول عبد الوهَّاب خلَّاف: «الأمم قديمًا كانت حالها لا تساعد على وجود صلات بين إحداها والأخرى لأنَّ القوية كانت تطمع في استبعاد الضَّعيفة، والضَّعيفة كانت في خوف من تغلُّب القويَّة، وما كانت إذ ذاك ضمانات تقف بالمطامع أو تنفي المخاوف، فلهذا كانت كل أمة في عزلة عن الأخرى، وما كانت لواحدة منها سياسة خارجية إلا تدبير الحروب والإغارات»([47]).
ولما كانت رسالة الإسلام دفع الضرر عن الخلق «لا ضرر ولا ضرار»([48])، أو بعبارة الفقهاء: «الضرر يزال»([49]) جاء الجهاد في الإسلام مقررًا لهذا المعنى؛ دفع الضَّرر عن هذه المقاصد الشرعية.
يقول الشَّيخ محمَّد أبو زهرة: «النَّبيُّ ﷺ قاتل لأمرين:
الأمر الأوَّل: دفع الاعتداء وقد وقع الاعتداء على الأنفس والأموال بالفعل، وما كان وهو الذي يدعو إلى الحقِّ الذي لا ريب فيه- أن يترك الباطل يستغلظ ويقوى، ويستخذي هو ويستسلم، فلا بد أن يضرب الباطل فيصيب من الشَّر دماغه، وهو الحكام المستبدون الظالمون، وإنَّ فضائل الإسلام إيجابية تقاوم، وليست سلبية تستسلم، ولذالك كان القتال وكان ماضيًا إلى يوم القيامة، ما بقي الشَّر ينازع الخير، ولذا قال ﷺ «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»([50]) لأنَّ اعتداء الخير على الشَّر ماضيٍ إلى يوم القيامة.
الأمر الثَّاني: تأمين الدَّعوة الإسلاميَّة، لأنَّها دعوة الحقِّ، وكلُّ مبدأ سامٍ يتجه إلى الدِّفاع عن الحرِّية الشَّخصيَّة، يهمُّ الدَّاعي إليه أن تخلو له وجوه النَّاس، وأن يكون كل امرئ حرًا فيما يعتقد، يختار من المذاهب ما يراه بحريةٍ كاملةٍ، ويختار ما يراه أصلح وأقرب إلى عقله»([51]).
والوضع الحالي للأمم ليس كحاله في الماضي، فالأمم حديثا– كما يقولون– كالقرية الواحدة، تؤثر كل واحدة في الأخرى وتحتاج كل واحدة للأخرى، وهذا دفعها إلى وضع تلك القوانين الَّتي تتعهد كلُّ دولة بتحقيقها بغضِّ النَّظر عن ماهيَّة هذه الدَّولة، هذه القوانين الَّتي تراعي أن يحافظ على حرية الشَّخص وعدم المساس بها، وبالتالي يتحقق ما هو مقرر في الشَّريعة الإسلاميَّة وهو حفظ الدِّين الَّذي شرع الجهاد في الأساس لأجل حفظه مع النَّسل وغير ذلك.
يقول عبد الوهَّاب خلَّاف: «ولهذا وضع علم القانون الدولي لتقرير القواعد الَّتي تستبين بها حقوق كلِّ دولةٍ وواجباتها قبل غيرها من الدُّول في حالي السِّلم والحرب. وأول ما قرره العلماء من قواعده أن تكون علاقات الدُّول أساسها السِّلم حتَّى يتيسَّر لها تبادل المنافع والتعاون على بلوغ النَّوع الإنساني درجة كماله وقرروا أنَّه لا يسوغ قطع هذه الصلة السِّلمية إلا عند الضَّرورة القصوى الَّتي تُلجئ إلى الحرب وبعد أن تفشل جميع الوسائل السِّلمية في حسم الخلاف. وسنُّوا لحال السِّلم أحكامًا تكفل لكل دولة حقوقها وواجباتها قبل غيرها حتَّى تقطع أسباب الخلاف بالقدر الممكن وسنُّوا لحال الحرب- إذا اضطر الخلاف إلى وقوعها- أحكامًا تخفِّف ويلاتها وتهوِّن من شرورها بالقدر الممكن كذلك»([52]).
إنَّ هذه المعاني الَّتي هي مقرَّرة في تلك القوانين في تعامل الأمم مع بعضها البعض كما هو معلوم مطالب من المسلمين تحقُّقها، ونشرها للعالمين فهي عين ما شرعت التشريعات لأجله، والَّتي منها الجهاد، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِين ﴾[الأنبياء: 107].
وهذا المعنى يقرره الخطيب الشربينيُّ من الشافعيَّة قائلًا: «وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد، إذًا المقصود بالقتال إنَّما هو الهداية وما سواها من الشهادة، وأمَّا قتل الكفَّار فليس بمقصودٍ حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدَّليل بغير جهادٍ كان أولى من الجهاد»([53]).
سبق أن بيَّنَّا دور الإمام وما جعله الإسلام له من سلطة في تقييد المباحات من أمور المعاملات فيما تقتضيه المصلحة العامَّة.
والجهاد يترتب عليه من الأمور ما بيَّنَّاه من تحقيق غاية الإسلام في حفظ المقاصد الشَّرعيَّة، ولذا جعل أمر الجهاد مرجعه للإمام ابتداءً وانتهاءً، بل وما يتعلق به.
قال في المغني: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرَّعيَّة طاعته فيما يراه من ذلك». وقال السرخسي في المبسوط: «على إمام المسلمين في كلِّ وقتٍ أن يبذل مجهوده في الخروج بنفسه أو يبعث الجيوش والسَّرايا من المسلمين ثمَّ يثق بجميل وعد الله تعالى بنصرته». وفي الشَّرح الكبير للدَّردير: «ونقل عن ابن عبد البر أنَّه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع الأمن»([54]).
و في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: « قال اللخميُّ عن الداوديُّ بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه »([55]) وفيه: « إن نهَى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلَّا أن يدهمهم العدوُّ»([56]).
«والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهمِّ جهة إذا كان العدوُّ في جهات، وكان ضرره في بعضها أكثر من ضرره في غيرها فإن أرسل الإمام لغير الأهمِّ أثم كما صرَّح به اللقانيُّ فإن استوت الجهات في الضَّرر خيِّر الإمام في الجهة الَّتي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع الجهات، وإلَّا وجب في الجميع، وإن كان في جهة واحدة يعيَّن القتال فيها»([57]).
قال الدكتور البوطي رحمه الله: «يعد الجهاد القتالي في مقدمة أحكام الإمامة، بل لا أعلم أيَّ خلافٍ في أنَّ سياسة الجهاد، إعلانًا وتسييرًا وإنهاءً ونظرًا لذيوله وآثاره، كل ذلك داخل في أحكام الإمامة، وأنَّه لا يجوز لأي من أفراد المسلمين أن يستقل دون إذن الإمام ومشورته في إبرام شيء من هذه الأمور».
وهذا الأمر بالطبع إذا لم يكن الجهاد العينيُّ بدخول العدو ديار الإسلام، قال رحمه الله: «إذن فنحن لا نتحدث الآن عن حالة النَّفير العام الَّتي تدخل في باب الصيال، وإن كان عموم معنى الجهاد يشملها وتنطبق عليها سائر أحكامه. وإنَّما نتحدث عن الجهاد القتاليِّ عندما يكون فرض كفاية على مجموع المسلمين لا على جميعهم أي كلِّ فرد منهم».
بعد أن ذكرنا مقاصد الجهاد في الإسلام وهي مقاصد يفخر بها المسلم فلقائل أن يقول: أنتم أيها المسلمون تتحدثون عن مقاصد الجهاد وأنَّ الجهاد أساسه نشر العدل والسِّلم في العالم وكتب الفقه لديكم مليئة بكل ما يعارض هذا، ويسرد لنا فروعًا فقهية وتفصيلات اجتهادية يأتي بها من كتب الفقه القديمة ليؤكد أن الجهاد في الإسلام قائم على التَّوحش والغدر والبطش، ونحن لا ننكر أنَّ مثل هذه الاجتهادات مسطورة في كتب التُّراث وهي في تفصيلاتها تحتاج لمناقشةٍ بشكلٍ إجماليٍّ، حتَّى نتفهَّم سبب وجود هذه الاجتهادات وبالتالي نعلم أنَّ ما هو موجود في هذه الكتب لا إشكال فيه عند النظر إليه في سياقه التَّاريخي، مع رفضنا لبعض الاجتهادات الَّتي لا دليل عليها، أو تلك القائمة على دليلٍ ضعيفٍ لا حجَّة فيه.
وبدايةً لهذه المناقشة نقول: إن هذه التَّفصيلات الفقهيَّة تتسم بصفات معيَّنة وهي:
أوَّلًا: أنَّها تنتمي إلى ما يسمَّى بالفقه المتغيِّر.
ثانيًا: هي تابعة في معظمها للأعراف الدولية السائدة في زمن صدورها.
ثالثًا: اندراجها تحت باب الوسائل في الفقه الإسلاميِّ.
رابعًا: مبنيَّة على المصلحة الَّتي قد تتغيَّر من حين لآخر.
خامسًا: بعضها قائمٌ على معانٍ فضفاضةٍ غير محددةٍ بحدودٍ من مثل النِّكاية في العدوِّ وإغاظته، وغيرها من المعاني الَّتي لا ضابط لها.
ومناقشة هذه التَّفاصيل الفقهيَّة سيتم ضمن الحديث عن هذه السمات بشكلٍ موسَّع حتَّى تتضح لنا الرُّؤية وتزول الإشكاليَّة:
- السِّمة الأولى: اندراج الاجتهادات في باب الجهاد تحت باب الفقه المتغيِّر:
إنَّ التفصيلات الفقهية في أحكام الجهاد ليست من باب الثَّوابت التي لا يجوز خرقها أو تغييرها، فمن المعلوم أنَّ أحكام الشَّريعة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أحكامٌ ثابتةٌ لا تتغيَّر مهما تغيَّرت الظُّروف من مثل أحكام العبادات والزواج والطَّلاق والميراث، فهذه الأحكام لا يطرأ عليها التغيير لأنها ثبتت بنصوص قطعيَّة الثُّبوت قطعيَّة الدَّلالة فلا سبيل إلى التبديل فيها.
القسم الثاني: أحكام قابلة للتغيير لأنَّها ثبتت بناء على اجتهاد من نصوص ظنيَّة الدَّلالة أو قياس وغير ذلك، وهذه الأحكام تتدخل فيها عوامل تجعلها تتغير كالمصلحة واختلاف الزَّمان والمكان، ويمثل لهذا القسم أحكام الإمامة والسِّياسة الشَّرعية، والنَّوازل التي لا نص فيها.
وسبب انقسام الأحكام هو انقسام الأدلة الشَّرعية إلى ظنيٍّ وقطعيٍّ يقول الشَّاطبيُّ في الموافقات: «كلُّ دليل شرعيٍّ؛ إمَّا أن يكون قطعيًّا أو ظنيًّا، فإن كان قطعيًّا؛ فلا إشكال في اعتباره؛ كأدلَّة وجوب الطَّهارة من الحدث، والصَّلاة، والزَّكاة، والصِّيام، والحجِّ، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، واجتماع الكلمة، والعدل، وأشباه ذلك، وإن كان ظنيًّا؛ فإمَّا أن يرجع إلى أصلٍ قطعيٍّ أو لا، فإن رجع إلى قطعيٍّ؛ فهو معتبر أيضًا، وإن لم يرجع؛ وجب التَّثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله»([58]).
يفهم من هذا النَّقل أنَّه بناء على اختلاف ثبوت الأحكام ودلالتها تختلف صفة الأحكام ما بين ثابت غير قابل للتَّبديل وضرب الشَّاطبي مثالًا عليه؛ كأحكام الصَّلاة والزَّكاة والصِّيام، ومنها ما هو جائزٌ فيه التَّغيير وهو ما يسمى بالفقه المتغيِّر.
والأحكام الفقهية التي نحن بصدد الحديث عنها والمبثوثة في أبواب الجهاد من كتب الفقه هي من أحكام الإمامة والسِّياسة الشَّرعيَّة التي ترجع فيها الأمور إلى نظر الحاكم وما يرى فيه من الأوفق والمناسب للمسلمين، ومثل هذه الأحكام هي من قبيل القسم الثَّاني فهي قابلة للتَّغيير؛ لأنَّها لم تقم على نصوص قطعيَّة الدلالة والثبوت، فمن المعلوم أن الاجتهاد لا يجوز فيما ورد فيه نصٌ قطعي الثبوت، قطعي الدَّلالة.
وإذا علمنا هذا كان من الممكن البحث في هذه الاجتهادات بما يحل الإشكال التي فيها طالما أنَّها قابلة للتَّغيير غير ثابتة.
السِّمة الثَّانية: أنَّ هذه التَّفصيلات الفقهيَّة متوافقة مع ما كان سائدًا من الأعراف الدوليَّة:
وهي التفصيلات الفقهية التي اجتهد الفقهاء المسلمون على أساسها بما يناسب ذلك الواقع، مما يعني أن تلك الاجتهادات كانت سائغة في وقتها، وبما أنَّ العرف الدوليَّ قد تغير اليوم حيث صار هناك اتفاقيات دولية تنظم حالة الحرب والسِّلم مع مواثيق مجلس الأمن لحقوق الإنسان وغير ذلك من المظاهر المشيرة إلى تغير الأعراف الدوليَّة في مسائل القتال- وجب احترام القوانين الدولية المنظمة لذلك الأمر، ولا يجوز التمسك باجتهادات وتفاصيل تجاوزها الواقع ولم يعد من المناسب ولا المحقق لمقاصد الشريعة التشبث بها، لأنَّ الزَّمان قد تغيَّر وبالتَّالي تغيَّرت معه الأعراف.
ومن المعلوم أنَّ العرف يعتبر من الأدلَّة التي تبنى عليها الأحكام، ويترك به القياس، وتخصص به النُّصوص عند جمهور الفقهاء، فينتج عن ذلك تغير الأحكام الاجتهادية التي بنيت عليه في حال تغيره، يقول الإمام القرافيُّ في الفرق بين قاعدة العرف القولي والعرف العمليِّ عند الكلام على اعتبار العرف وتغيره: فمهما تجدَّد العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه ولا تجمُد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك لا تجرِه على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجرِه عليه وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحقُّ الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدِّين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسَّلف الماضيين»([59]).
والعرف في نظر الشَّريعة الإسلاميَّة له سلطان واسع المدى في توليد الأحكام وتجديدها وتعديلها وتحديدها وإطلاقها وتقييدها؛ لأنَّ العرف وليد الحاجة المتجددة والمتطورة، وقد قام العرف بدورٍ هام في تفسير ألفاظ الأحكام وإنشاء أحكام جديدة وتعديل أحكام قائمة، وأحكام الجهاد من الأحكام التي تتأثر بتغير العرف وبالتالي يجوز تعديلها بما لا يخالف أصلًا من أصول الدِّين وقطعياته.
ومن المقرر في فقه الشَّريعة أن لتغيُّر الأوضاع والأحوال الزمنية تأثيرًا كبيرًا في كثير من الأحكام الاجتهادية التي تنظم ما أوجبه الشَّرع، وأحكام الجهاد هي في جوهرها تنظيم لما أوجبه الله من فريضة الجهاد، وبالتالي إذا عرض ما يفرض تغيير هذا التنظيم فذلك سائغ لا إشكال فيه، وخاصة أن كثيرًا من الأحكام الاجتهادية كانت تدبيرًا وعلاجًا ناجعًا لبيئة في زمن معيَّن فأصبحت بعد جيلٍ أو أجيال لا تُوصل إلى المقصود أو أصبحت تفضي إلى عكسه لتغير الأوضاع، ومن هنا أفتى الفقهاء المتأخرون من شتى المذاهب الفقهية في كثير من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهائهم، وصرَّح هؤلاء المتأخرون بأنَّ سبب اختلاف فتواهم عمن سبقهم هو اختلاف الزَّمان.
وكتب الفقهاء طافحة بنصوص تعتبر العرف وتعده مصدرًا من مصادر الشَّريعة وتقوم بمسايرته في أحكام اليمين والنذر، فمن باب أولى أن نعتبره في أحكام القتال والجهاد، فلماذا لا يكون لتغيُّر العرف أثر في تغيُّر هذه الأحكام، وخاصَّة أنَّ العلماء لم يوجبوا في اجتهاداتهم الفقهية كيفيَّة معينة في القتال مع العدوِّ، بل ذكروا أحكامًا لأعمال حربية كانت منتشرة في ذلك الوقت ضمن إطار الفقه العام، والشَّريعة الإسلاميَّة صالحة لكلِّ زمانٍ ومكان لما فيها من قواعد مرنة تكفل لها التجدُّد في كلِّ عصر بما يتوافق مع حال العصر وأعرافه.
وعلينا أن نلفت النظر هنا أنَّ الأعراف الدوليَّة إذا صادم منها ما هو قطعي الدَّلالة والثُّبوت في ديننا فلا يؤخذ به ولا يراعى أبدًا، أمَّا إذا كان العرف الدولي مما يسير في فضاء الأحكام الاجتهادية القابلة للتغير فلا ضير على المسلمين أن يلتزموا به، وبالتالي يستنبطوا اجتهادات تساير هذه الأعراف التي هم جزء من تكوينها وقد قبلوا بها من قبلُ طالما لم تعارض دليلًا أو أصلًا من أدلة وأصول الشَّريعة الإسلاميَّة.
- السِّمة الثَّالثة: اندراج أحكام الجهاد تحت باب الوسائل في الفقه الإسلاميِّ وليست من المقاصد في شيء.
الأحكام الفقهية في أبواب الجهاد هي للوسائل القتالية التي تتم خلال الحرب مع الأعداء وهذه الوسائل هي وسيلة للجهاد والذي هو وسيلة لتحقيق مقاصد أشرنا إليها في الحديث عن مقاصد الجهاد في الإسلام يقول العزُّ بن عبد السَّلام: «وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الَّذي هو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل»([60]).
إذا علمنا هذا فعلينا أن نعلم أنَّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وأنَّ فضل الوسيلة مترتب على فضل المقصد جاء في كتاب القواعد الصُّغرى للإمام العزِّ: «للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة... واعلم أن فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد والأمر بالمعروف وسيلة إلى تحصيل ذلك المعروف والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر»([61]).
إذًا حكم الوسائل هو حكم المقاصد فالأحكام التي وضعت في أبواب الجهاد لوسائل القتال أثناء جهاد المسلمين لها حكم مقاصد الجهاد، وبما أن الوسائل متغيِّرة والمقاصد ثابتة فقد تتغيَّر الظُّروف والأحوال وتصبح وسائل الأمس غير مناسبة لواقع اليوم، نقول هذا ونحن نعلم تأكيد العلماء على أنَّ الوسيلة لم تكن يومًا مقصودة لذاتها يقول الإمام الشَّاطبيُّ: «وقد تقرَّر أنَّ الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودةٍ لأنفسها، وإنَّما هي تبعٌ للمقاصد بحيث لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بها، وبحيث لو فرضنا عدم المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث»([62]).
ويقول في موضعٍ آخر: «فلا يمكن والحال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء القصد، إلَّا أن يدل دليلٌ على الحكم ببقائها، فتكون إذ ذاك مقصودةً لنفسها»([63]).
يؤكِّد الإمام القرافيُّ القاعدة هذه بقوله: «القاعدة أنَّه كلَّما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنَّها تبعٌ له في الحكم»([64]).
إذًا الوسائل ليست مقصودةً لذاتها بدليل أنَّ انتفاء المقصد كافٍ في انتفاء الوسيلة وعدم الالتفات إليها، وبما أن الوسائل غير ثابتة والمقاصد هي الثَّابتة فلا نجد أنفسنا ملزمين باتباع الأحكام الفقهية لوسائل الجهاد القديمة الَّتي كان لها ظروفها وأحوالها إذا كان ثمة وسائل أخرى تفي بالمقصود، وخاصَّة أنَّنا علمنا أن أحكام الجهاد هي من قبيل الأحكام القابلة للتغيير.
وبما أنَّ الحديث عن الوسائل فلنعلم أنَّ أيَّ وسيلة تؤدِّي إلى مقصدٍ مشروع ينبغي أن لا يترتب عليها مفسدة، فإذا صادفتنا وسيلةً من الوسائل أثناء الجهاد يترتب عليها ضرر أو فيها مفسدة تكرُّ على مقاصد الجهاد بالبطلان فالوسيلة عندئذ تُلغى ولا يُلتفت إليها.
فالعبرة في الوسيلة أن تُحقِّق مصلحةً راجحة؛ لأنَّها كما ذكرنا ليست مقصودةً بعينها؛ ولذلك وجدنا الفقهاء يجيزون دفع المال إلى الأعداء من أجل فكِّ الأسرى المسلمين، أو دفع المال لهم اتقاء شرِّهم، مع أنَّ هذا الفعل إذا نظر إليه بعينه دون النَّظر إلى مسألة المقاصد والوسائل لكان محرمًا، لكن لما كانت هذه الوسيلة تجلب مصلحة راجحة أخذنا بها، يقول الإمام القرافيُّ: «قد تكون وسيلة المحرم غير محرمةٍ إذا أفضت إلى مصلحةٍ راجحة كالتَّوسُّل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفَّار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشَّريعة عندنا وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك- رحمه الله تعالى- ولكنَّه اشترط فيه أن يكون يسيرًا، فهذه الصُّور كلُّها الدَّفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة»([65]).
وعلى كلٍّ فالوسيلة إذا لم تُفض للمقصد الَّتي وضعت من أجله سقط اعتبارها([66])، وهذا يطبق على أحكام الوسائل القديمة في الجهاد فإنَّها إذا لم تؤدِّ إلى مقاصد الجهاد في واقعنا الذي نعيش فيه من نشر السِّلم والعدل فلا اعتبار لها، فنحن لسنا متعبدين بها.
- السِّمة الرَّابعة: الاجتهادات الفقهيَّة في أبواب الجهاد مبنيَّة على المصلحة.
أحكام الجهاد التي نجدها مبثوثة في كتب الفقه هي في معظمها تلحظ المصلحة، فالفقهاء عند استنباط أحكام القتال كانت مصلحة الإسلام والمسلمين منطلقهم، وهذا كلام لا غبار عليه، وهو ملاحظ عند كل من اطَّلع على نصوصهم الفقهيَّة، والنَّاظر اليوم إلى أحوال المسلمين يجد أنَّ المصلحة التي كانت بالأمس منطلقًا لأحكام الفقهاء ليست هي نفسها الآن، فالإسلام في ضعفٍ والمسلمون في استضعافٍ وتأخُّر يدمي القلب وبالتالي فالمصلحة قد تغيرت وتبدلت، والأحكام تتغير تبعًا لتغير المصلحة، ويمكن لنا أن ننتقل من حكمٍ كان معمولًا به إلى حكمٍ آخر لمصلحةٍ طرأت علينا فرضتها الظُّروف والأحداث التي نعيشها، وعلينا أن نؤكِّد على مسألة مهمة في هذا السِّياق وهي أن جمهور الفقهاء يخصون التَّبديل بالأحكام في إطار ما لا نص فيه ولا إجماع صحيح؛ وذلك سدًّا لباب التَّلاعب بالدِّين وتحكيم الهوى والغرض، والقول بالتبديل بصفةٍ عامَّةٍ عند اقتضاء المصلحة ذلك قال به العلماء ممن فهموا روح الشَّريعة ومراميها ويذكر ابن القيم أنَّ تغيير الفتوى بحسب الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد معنى عظيم النفع جدًا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشَّقة ما يُعلم أن الشَّريعة لا يعقل أن تأتي به([67]). وهذا النقل يؤيد ما نقول به من تبديل الأحكام المبنيَّة على المصلحة حتى لا يكون هناك انفصال بين الأحكام الفقهية وبين شؤون الناس ومصالحهم، فإن ذلك الانفصال لا يتفق مع ما عُلم من الدِّين بالضَّرورة من أن الشَّريعة صالحة لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، فكان لا بد من أن تساير الأحكام شؤون النَّاس ومصالحهم ما دام ذلك متفقًا مع روح الشَّريعة ومسايرًا لما يفهمه الأئمة والفقهاء من اتجاهاتها.
إذًا التَّصرُّف في الأحكام إذا اقتضته المصلحة أمرٌ مشروع؛ كما يدل عليه تصرفات الصَّحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الَّذي طالما غيَّر بعض الأحكام إلى ما يرى أنَّه مصلحة، مع تفسيره للنُّصوص تفسيرًا يتفق مع المصلحة، وهي تصرفات تبيِّن أنَّ تغييرات الأحكام تبعًا للمصلحة في عصر الصحابة كانت كثيرة، وهو ما درج عليه التابعون، والفقهاء من بعدهم.
ثم إن الحكم المجتهد فيه لا ينبغي أن يكون لزامًا على الناس لا يقبل تحويلًا ولا تبديلًا فقد روي عن الإمام عليٍّ أنه قال: قلت: يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشَّاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب([68]).
وهذا يدل على أن مراعاة المصلحة أمرٌ له خطره ويسمح بالتصرُّف حتى في أثناء نزول الوحي مادام الشَّخص في مكان تدعو ظروفه إلى التَّصرف([69]).
وهذا الذي نحن بصدده من أحكام واجتهادات فقهية في أبواب الجهاد إذا وجدنا أن مصلحة المسلمين والإسلام قد تتضرر فلسنا مجبرين على العمل بها، فسلفنا رضي الله عنهم الذين وضعوا هذه الاجتهادات لم يعيشوا وقتنا، وهذا سرُّ عبارة المصطفى ﷺ الشَّاهد يرى ما لا يرى الغائب ونحن الآن شهود على حال المسلمين وما يناسب مصلحتهم، ثمَّ إن الاجتهادات الفقهية في باب الجهاد من قبيل تصرفات الحاكم والسِّياسة الشَّرعية كما علمنا والتي ينظر فيها في المقام الأول إلى المصلحة العامَّة، فإذا تغيرت هذه المصلحة تغيرت معها الأحكام تبعًا.
- السِّمة الخامسة: إناطة بعض أحكام الجهاد بمعانٍ عامَّة؛ كنكاية العدوِّ وإغاظته:
المطَّلع على أبواب الجهاد في كتب الفقه الإسلامي يجد فيها أحكامًا مرتبطة بمعانٍ عامة قابلة للتغير بحسب الزَّمان والمكان، فمثلا مسألة النكاية في العدوِّ وإغاظته التي ارتبطت فيها أحكام كثيرة هي مسألة اعتبارية تخضع لعوامل مختلفة تجعل الحكم متغيرًا بتغير تلك العوامل، فما يكون فيه نكاية بالعدو في زمن قد لا يكون مثله في آخر، وما يغيظ العدو في حال قد لا يغيظه في آخر، ثمَّ إن الموضوع قد يختلف باختلاف العدوِّ نفسه وما هي قدراته وإمكانيَّاته، فما ذكر من أحكام لتحقيق النكاية بالعدو وإغاظته هو في طبيعة الأمر مبنيٌّ على ما كان سائدًا في ذلك الوقت، فقد تطبق نفس الأحكام اليوم ولا تحصل النكاية بالعدوِّ.
ثمَّ إن تطبيق أحكامٍ فقهية في كتب الفقه في هذا العصر تحت بند النكاية بالعدو قد يترتب عليه إضرار بالإسلام والمسلمين؛ كتشويه صورة الإسلام والتنفير منه، وهذا ليس من الفقه في شيء، وخاصَّة أنَّنا نعلم أنَّ تحقيق مقاصد الجهاد هو الأساس وهو الواجب على المسلمين، فليس مقصود المسلمين في الجهاد هو القتال من أجل القتال، وبالتالي فمسألة النكاية والإغاظة بالكفَّار لم تكن أساسيَّة في فقه الجهاد، بل العبرة هو نشر تعاليم الإسلام وقيمه من أجل أن يسود السَّلام والعدل في العالم.
قد يقول قائل: إن هذه المعاني من إذلال العدو والنكاية فيه نحن محتاجون إليها إذا كان العدو قد اغتصب أرضنا فكل ما يمكن أن يلحق الغيظ والذُّلَّ والهوان فيه هو مطلوبٌ ومشروع. قلنا: إنَّ هذا حق كفلته جميع الشَّرائع، ودفع العدوِّ مطلوب بكل الوسائل، ولكن ينبغي أن تكون الأمور منضبطة ومتوافقة مع مصلحة الإسلام والمسلمين، دون إلحاق ضررٍ أكبر بهم، فالمسألة تحتاج إلى وعيٍ وفقهٍ كبيرين، ولا يمكن أن نستلَّ من كتب الفقه أحكامًا وضعت في حالةٍ مخصوصة وزمنٍ مخصوصٍ ونطبقها بحجَّة أنَّ هذه الأحكام أنيطت بنكاية الأعداء وإغاظتهم، فأحكام الفقه المرتبطة بمعان متسعة هي أحكام صفتها التَّغيُّر والتَّبدُّل لاتِّساع المعاني المناطة بها، فما جدوى أن نقوم بفعل كان يؤدِّي إلى نكاية العدو في الماضي، ولا أثر له في الحال إلا جلب الهلاك والدَّمار على المسلمين.
إذا نحن لسنا ملزمين بتطبيق مثل هذه الأحكام والعمل به، ففقهاؤنا رحمهم الله كانوا محكومين بعصرهم، وهم لم يعيشوا عصرنا، فمن الخطأ أن نعيش عصرهم في زماننا هذا، وقد تركوا لنا قواعد عامة نسير على هداها، وربما لو كان الواحد منهم في زماننا لتراجع عن كثير من الأحكام التي أفتى بها في زمانه بهدف إغاظة الكفَّار، فكما قلنا إنَّ ما يغيظ العدو في الأمس قد لا يفعل فعله الآن.
ثانيًا: إشكاليَّة التغاير بين بعض أحكام الجهاد وبين المواثيق والمعاهدات الدولية:
النَّاظر في كتب الفقه الإسلاميِّ يجد أنَّ بعضًا من أحكام الفقه في باب الجهاد قد تظهر مغايرة مع ما نصَّت عليه بنود المواثيق والمعاهدات الدوليَّة، فمن المعلوم أنَّ المجتمع الدولي قد قام بعقد اتفاقات دوليَّة في شأن الحرب والسَّلام، ونذكر على سبيل المثال من بين هذه الاتفاقات اتفاق سبتمبر 1949م في خصوص تحسين مركز المرضى والجرحى في ميدان القتال، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية المدنيين في وقت الحرب.
ويتضمَّن الباب الثَّاني من الاتفاق أحكام الحماية العامَّة للسكان المدنيين من عواقب الحرب، وفي هذا الشَّأن أشار الاتفاق إلى أنَّ جميع الأحكام واجبة التطبيق على مجموع سكان الدولة المشتركة في النزاع دون أي تمييز.
ويحظر الاتفاق مِن جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفًا للهجوم، أو شن هجوم عشوائي يصيب السُّكان المدنيين أو المناطق المدنية، وغير ذلك من بنود.
وفي الاتفاق بنود أخرى لسنا بصدد الحديث عنها ومثل هذا الاتفاق معاهدات واتفاقيات دولية تشير إلى ما يشير إليه.
والإشكالية الآن أنَّنا إذا أردنا أن نطبق جميع الأحكام الفقهية المسطرة في أبواب الجهاد سنجد أنفسنا أمام أحكام مخالفة لما نصت عليه هذه الاتفاقات والمعاهدات، فما العمل عندئذ وما الحل؟
ولنضرب مثالًا يوضح الصُّورة أكثر ويجلِّيها لنا فالفقهاء في كتبهم ينصون أنَّه في حال قامت الحرب بين المسلمين والكفَّار المحاربين جاز للمسلمين أن يقتلوا كل من كان مطيقًا للقتال سواء شارك في القتال أم لم يشارك، وفي هذا الإطار يقول الإمام الكاساني: «والأصل فيه أن كلَّ من كان من أهل القتال يحل قتله، سواء قاتل أو لم يقاتل، وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطَّاعة والتحريض، وأشباه ذلك على ما ذكرنا، فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس، والذي يجن ويفيق، والأصم والأخرس، وأقطع اليد اليسرى، وأقطع إحدى الرجلين، وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم من أهل القتال»([70]).
والآن وبعد سرد هذا النص ما هو موقفنا في ظل المواثيق والمعاهدات المهيمنة على العلاقات الدولية؟
بادئ ذي بدء نقول إنَّ هذه الأحكام كما رأينا تتغاير في ظاهرها مع المواثيق الدولية في هذا العصر، والتي تحظر على الدول المتنازعة قتل المدنيين حتى وإن كانوا مطيقين للقتال، وتعتبر قتلهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي، ولكنها اجتهادات سائغة بحسب ما كان موجودًا في العصور الفائتة، وهي منسجمة مع الأعراف الدولية في حينها، ففي المسألة سالفة الذكر مثلًا التغاير ظاهريٌّ ولا تناقضَ أو تضادَّ بين مراد القانون الدولي وما يبغي إليه النص الفقهي، فاعتبار الفقهاء جواز قتل العدو المطيق للقتال وإن لم يقاتل لأمرين؛ الأول: طبيعة المقاتل، وثانيا: الأسلحة المستخدمة حينئذ، فالمقاتل لم يكن من شروطه أن يكون تحت مظلة جيش نظامي مدرَّب، كذلك فالأسلحة البسيطة المستخدمة حينها يستطيع من له الطاقة والقوة القتالية أن يستخدمها في إيذاء الآخر أو قتله، وذلك للتكافؤ بين الأدوات الهجومية والدفاعية البسيطة البدائية كما هو معلوم.
أما في العصر الحديث فالمقاتل له طبيعة خاصة، فهو يقاتل تحت راية جيش نظامي، وله رتبة بداية من مرتبة الجندي إلى ما يعلوها من رتب، كذلك له ما يميزه من زيٍّ غالبًا، وله من التدريبات الخاصة سواء على الناحية البدنية أوالقتالية أو المهنية في استخدام السلاح المعقد المتطور تكنولوجيًّا مما يحتاج مهارة خاصة في استعماله لا تتوفر للرجل العادي وإن كان مطيقًا للقتال، كذلك للمقاتل من الوسائل الدفاعية الحصينة ما لا يستطيع الرجل الأعزل وإن كان له من قوة الجسد أوالمهارة أن يقف أمامها وإن تقلد من الأسلحة البدائية، فصار الأعزل في حكم المدني وإن كان مطيقا للقتال.
ظهر بذلك أن الصورة الفقهية لم تتناقض مع ما قرره القانون الدولي، وإنما كانت مغايرة لتغير العوامل والظروف لا أكثر؛ ولو عاش الفقهاء لحين زماننا لقالوا به.
ثمَّ إن هذه المسألة وأشباهها من باب المباح حيث لا يوجد وجوب بقتل كل من أطاق القتال أثناء الحرب، وبالتالي فنحن غير مضطرين إلى العمل بها، وخاصة أن الدول الإسلاميَّة قد وقَّعت على هذه المواثيق وقبلت الالتزام بها، وبما أنه يجوز للحاكم تقييد المباح، فلا يعمل بأي حكم ناقض تلك المعاهدات، ثمَّ إن العمل بنقيضها هو نكث للعهود التي أمرنا الله بالوفاء بها فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1] وقال: ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا ﴾ [الإسراء: 34].
وقد حذَّر رسول الله ﷺ من عدم الوفاء بالعهد ووصف فاعله بنقصان الدين فقال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»([71]). وقال ﷺ: «من أعطى بيعته ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه»([72])، وقد جعل المصطفى ﷺ ناكث العهد منافقًا خالصًا فقال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر»([73])، وألزم النبي ﷺ أتباعه بالشروط التي التزموا بها في عقودهم واتفاقاتهم فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»([74]).
والآيات والأحاديث الَّتي ذكرنا عامَّة تشمل المسلم والكافر فنقض العهد مع الكافر كنقضه مع المسلم بل إن نقضه مع الكافر أشد خطرًا لما فيه من تشويه لصورة الإسلام والمسلمين عند الكفَّار ممن سمع بأخلاقيات الإسلام، فلا يجدر أن نريه عكسها في تصرفاتنا.
ويدل على عدم التفريق بين المسلم والكافر في الوفاء بالعهد أن رسول الله ﷺ نهى عن نقض العهد مع الكفَّار حتَّى ينقضي أمده، أو ينبذ العهد إلى المعاهدين جهرًا حتى لا يغدر بهم. فقال ﷺ: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء»([75]).
ولا يقال إن في التزام المسلمين بأحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية إعراض عن أحكام الشَّريعة، فهذه دعوى عريضة لا دليل عليها فكل ما في الأمر أنَّنا وجدنا كلام الفقهاء في هذه الأمور من باب الإباحة لا الوجوب فهو كلام تنظيمي يسير عليه المجاهد فيحدد تصرفاته بيجوز ولا يجوز، وإذا كان الأمر كذلك ساغ لنا أن لا نلتزم هذه الأحكام لأنَّها تنظيمية تختلف بحسب الوقائع والأزمان
وعلى هذا الأساس فالتزامنا بالمعاهدات لا شيء فيه ما دام لا يناقض أصلًا من أصول الدِّين أو قطعيًّا من قطعيَّات الشَّريعة.
***