أرشيف الفتاوى
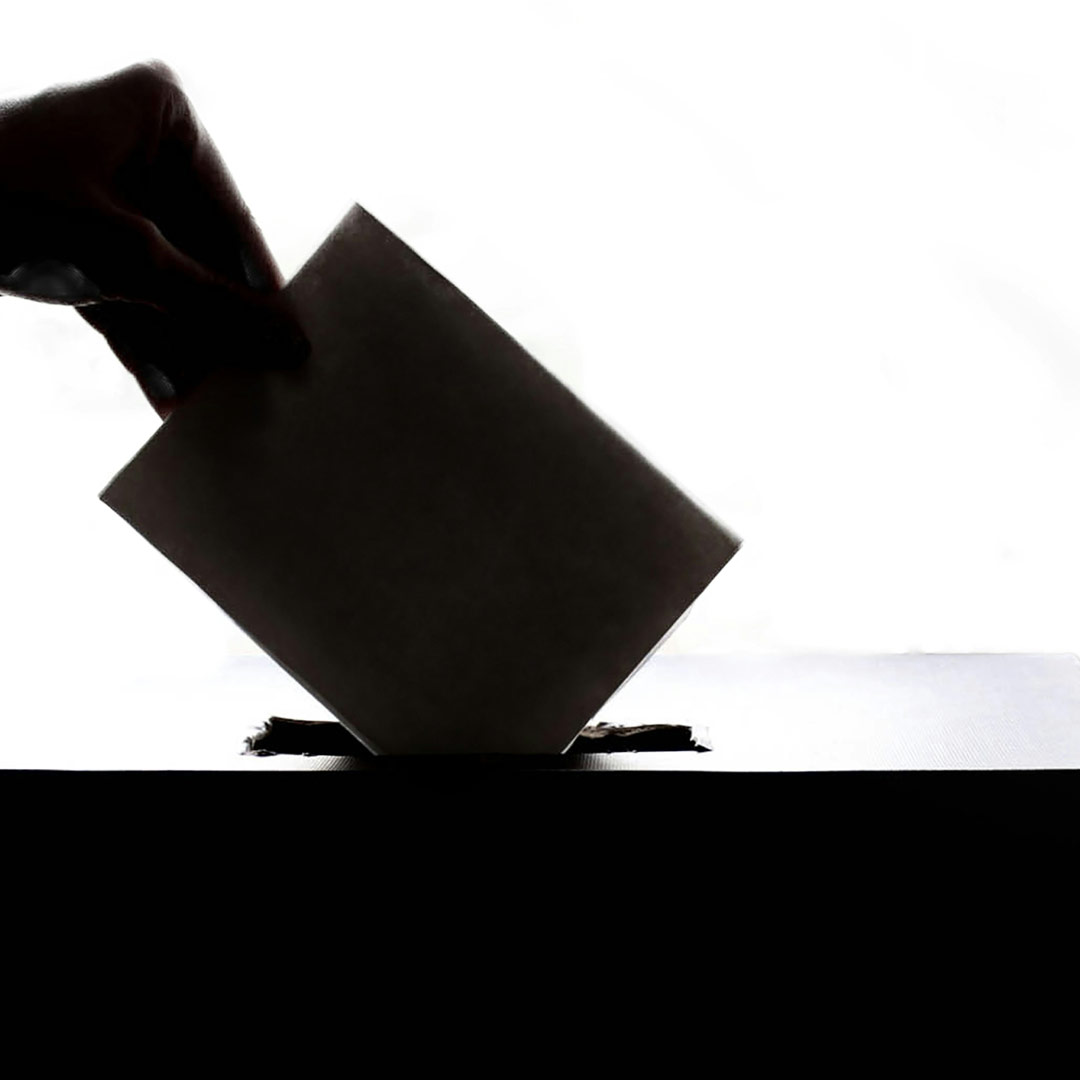

أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة للجنس البشري، حاملًا للمنهج الرباني الذي أراد الله عز وجل لبني آدم السير عليه، وكان من أبرز خصائص هذا المنهج رعاية مصالح الخلق والرفق بهم ونفي الحرج عنهم، فلم تكن شريعة الإسلام مجرد أوامر ونواهي وتكليفات تنفصل عن حياة الإنسان وواقعه الفردي والجماعي على أي مستوى من المستويات؛ وإنما كانت شريعة حية ودينًا متجددًا متفاعلًا، يجعل من أهم أولوياته مصلحة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وتحقيق سعادته في آخرته.
وإذا نظرنا إلى معالم الشريعة الإسلامية ومحاورها، فإننا نجد منها:
- الثابت القطعي؛ المجمع عليه من أمة الإسلام والذي لا تتغير مفاهيمه ومعانيه من أبواب الاعتقاد وتوحيد الله عز وجل ومعاني الإيمان، ومعالم الدين الكبرى من معرفة الرسل والكتب والإيمان باليوم الآخر وعالم الغيب، إلى جانب الثابت القطعي غير المتغير من التشريعات وأحكام الفقه الإسلامي الضابطة لعبادات ومعاملات المسلمين، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من القيم والأخلاق الحاكمة لسلوك الإنسان، هذه العناصر الثلاث تتسم بالثبات وعدم التغير أو التبديل في حقيقتها كمكون لهذا الدين الإسلامي العظيم، وتتسم كذلك بالثبات كوجود واعتقاد بالنسبة لجماهير الأمة المسلمة.
- المتغير والظني؛ وهو جانب من الشريعة الإسلامية وتكليفاتها وأحكامها يتسم بالمرونة وعدم الثبات واتساع أوجه الاحتمال في معانيه ودلالاته، هذا الجانب يتعلق به مساحة واسعة من الاجتهاد المتعلق بالنظرة الشرعية للمتغيرات الحياتية من حيث طبيعة المعاملات المستحدثة، وهيئة أداء العبادات (وليس أصلها وأركانها)، هذه المساحة من الاجتهاد والنظر وإعمال الفكر من العلماء أهل الاختصاص تؤصل لحقيقة أن دين الإسلام وشريعته لم يكن في أي وقت من الأوقات يتصف بالجمود.
وبالنظر إلى قول الله عز وجل عن هذه الشريعة ووصفه سبحانه وتعالى لها: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 161].
وإلى التعريف الاصطلاحي للدين عند علماء المسلمين: «الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات، وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي ﷺ المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا، ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة، ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة»([1]).
وإلى حديث النبي صلى الله عليه الذي يؤصل لمساحة الاجتهاد والنظر في شريعة الإسلام؛ فعَنِ الحارثِ بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن ناسٍ من أصحابِ معاذ من أهل حِمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ حين بعثه إلى اليمن فقالَ: «كَيْفَ تصنعُ إنْ عرضَ لك قضاءٌ؟» قال: أقضِي بما في كتابِ الله. قال: «فَإنْ لم يكنْ في كتابِ الله؟» قال: فبسُنَّةِ رسول الله ﷺ. قال: «فإنْ لم يكنْ في سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ؟» قال: أجتهدُ رأيي ولا آلُو. قال: فضربَ رسول الله ﷺ صدري، ثمَّ قال: «الحمدُ لله الَّذي وفَّقَ رسُولَ رسُولِ الله لما يُرضِي رسولَ الله»([2]).
يتبين لنا من خلال ما سبق أن أمر الدين والشريعة يتكون من:
- عقيدة ثابتة مصدرها إلهي، لا تتبدل ولا تتغير، تتوافق مع كل عقل وفكر وزمان ومكان وأحداث وأشخاص ووقائع، ليس بها تناقض أو اختلاف أو تضاد.
- منظومة أخلاقية قيمية ثابتة مصدرها إلهي، لا تتبدل ولا تتغير، تتوافق مع حياة الإنسان ومتطلباته، حاكمة للسلوك البشري.
- منظومة تشريعية تتكون من:
أ- جانب ثابت مصدره إلهي (قرآن، وسنة) لا يتبدل ولا يتغير.
ب- جانب متغير اجتهادي، يتم النظر فيه إلى الزمان والمكان والأحوال والأشخاص واعتبار أثرهم في النظرة الشرعية للمسائل، وهذا الجانب المتغير غير منفصل عن الجانب الثابت، بل هو يستمد منه ويدور في فلكه ومعانيه الشرعية.
ومما سبق من المعاني يتأكد لدينا أن القول بجمود الدين الإسلامي وعدم مرونته فكرة غير واردة على الإطلاق، وليس لها نصيب من الصحة؛ فقد جاء الدين لتصحيح العقيدة وتقويم السلوك والأخلاق، وكذلك رعاية مصالح الناس بما يتفق مع الثوابت والقطعيات الشرعية، فطبيعة الدين الإسلامي من حيث اتصافه بالشمول والكمال والتوازن والوسطية، والواقعية والإيجابية، وخصائصه التفاعلية الدائمة المستمرة التي لا تصطدم بأي عائق تنفي عنه فكرة الجمود وعدم مواكبة الحياة، فهو متفاعل مع تطور الحياة ومرونتها.
ويكفي للدلالة على تفاعل الدين الإسلامي وعدم جموده، الوقوف على نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تحمل في داخلها اعتبار العمل على تحقيق جميع حاجات الإنسان المادية والمعنوية، حيث اشتملت على تحقيق: الضروريات (حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل)، والحاجيات (وما تشتمل عليه من رفع الحرج والضيق والمشقة)، والتحسينات (وتشمل رعاية الأخلاق والجانب القيمي ومحاسن العادات وأنماط العيش).
هذه المقاصد الشرعية التي تتسع لكل عصر ولجميع أنماط الحياة وصورها، تؤكد حقيقة سعة الشريعة الإسلامية وعدم جمودها وقدرتها على الوفاء بحاجات الجنس البشري على هذه الأرض في كل الأحوال والأوقات.
ولو افترضنا على سبيل الجدل أن شريعة الإسلام كعقيدة وأحكام وقيم تتسم بالجمود، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال ملح وهو أين مظاهر هذا الجمود وآثاره؟!!
وبالاستقراء والبحث والتنقيب فإننا لن نجد أي أمثلة لحدوث تصادم أو تعارض أو تضاد بين أي جانب من هذه الجوانب الثلاث ( العقيدة، التشريع، القيم) وحياة المسلمين ومصالحهم ونمط حياتهم في مجتمعات الأمة وحياة أفرادها عبر القرون، فهذا لم يقع أبدًا في أي مرحلة منذ الصدر الأول للإسلام وحتى يومنا هذا؛ فلم تتعارض عقيدة الإسلام بكلياتها وجزئياتها مع العقل أو واقع الأمور وحقيقتها وطبيعة الخلق ووجود الإنسان على هذه الأرض؛ بل هي منسجمة متناغمة مع العقل والروح والنفس والحواس، ولم يتعارض التشريع بكلياته وفروعه وأحكامه مع رعاية مصلحة الإنسان وضبط معاملاته وعباداته، ولم نر في أي وقت ظهورًا لمشكلات وعوائق بسبب التشريع الإسلامي وأحكامه، وكذلك الأمر بالنسبة للمنظومة القيمية الأخلاقية في الإسلام والتي قدمت لنا أعلى نماذج الإنسانية والرقي على المستوى المجتمعي والفردي عبر تاريخ الأمة الإسلامية.
ولو بحثنا عن تصديق هذه الحقيقة لوجدنا مظاهرها بدأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع قواعد مواكبة الشريعة الإسلامية لمتطلبات الحياة، فقال: «بعثت بالحنيفية السمحة»([3]). وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا»([4]).
فحياة النبي صلى الله عليه وسلم وما احتوت عليه من النماذج المعيشية على المستويات المختلفة الفردية والجماعية تصلح مرجعية كلية، يأخذ منها المسلمون قواعد شرعية عامة لمواجهة متطلبات وطابع الحياة الحديثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية، فنموذج حياته وهديه الكريم صلى الله عليه وسلم به من المعالم الهادية التي تجعل منه منهجًا مباركًا لأمته في كل زمان ومكان وحال، ويشهد بقدرة هذه الشريعة على التوافق والتداخل مع مختلف صور الحياة الإنسانية.
فلم تتصادم الشريعة الإسلامية مع الحتمية الزمنية وطبيعة الأشياء وإنما توافقت معها وألحقت مظاهرها وصورها الحديثة بالكليات الشرعية، فيعمل أهل الاختصاص على النظر والاجتهاد كما اجتهد من سبقهم من العلماء، للعمل على خلق موقف شرعي يتسق مع أصول الدين ويحقق المصلحة الإنسانية، ويراعي واقع المجتمعات الحديثة وانفتاح العالم كله على بعضه البعض، وزوال الحواجز الزمانية والمكانية بين الجنس البشري، وما أنتجه ذلك من وجود ثقافة عالمية تكاد تكون موحدة تفرض على المسلمين تحديد موقفهم من قضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وهنا يأتي دور النظر والاجتهاد الذي يعمل على تقديم الرؤية الشرعية التي تواكب ذلك وترعى المصلحة وتحققها وفي الوقت نفسه تحترم الثوابت وتحفظ هوية الأمة.
والفقه الإسلامي ليس بجامد بل نجد فيه منظومة متكاملة من الآراء الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، تصلح لأن تكون منهجًا للتعامل مع القضايا المستحدثة والمسائل المعاصرة، وذلك على جميع المستويات، مع مراعاة الأبعاد المكانية والزمانية والعرفية والمعرفية، وحد الضرورة والحاجة، والإكراه والاضطرار، وكيفية تحقيق المصلحة وتجنب المفسدة، ومع تراكم هذه المعالم الاجتهادية وأدوات النظر ينفتح الطريق أمام معاني التطور المنضبط الذي يحقق المقاصد ويحترم الثابت ويواكب العصر.
والأمثلة والصور على مرونة تعامل الدين مع الحياة وعدم جموده أو انغلاق المسلمين على أنفسهم ظهرت منذ عهد النبوة في جوانب عديدة منها الاقتصادي والعلمي والاجتماعي، فعلى سبيل المثال قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل فداء الأسرى لمن لا يمتلك المال تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وكانت الرحلات التجارية تتواصل مع بلاد الشام واليمن من المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يحمله ذلك من صور التعايش والتعاون والتبادل والتسامح بين المسلمين وغيرهم.
وإذا نظرنا إلى الجانب الاجتماعي لمجتمعات المسلمين، فلن نجد أن الدين يقف عائقا أمام ممارسة الحياة الطبيعية بين أفراد المجتمعات من حيث تعامل أفراده واختلاطهم وتعايشهم مع بعضهم البعض، وجميع صور الحياة الاجتماعية الحديثة وأنشطة الحياة، بل يضع الدين الضوابط التي لا تعطل مصالح الناس وتحفظ القيم والأخلاق، وكذلك الحال في العلاقة بين مجتمعات المسلمين والمجتمعات الأخرى لا يقف الدين حائلًا بين التواصل والتعاون؛ وإنما يشجع التعارف والتواصل والاستفادة من الخبرات في شتى المجالات، وخير مثال على ذلك هو حال الصحابة رضي الله عنهم مع أبناء المجتمعات الجديدة التي نزلوا بها.
كذلك حملت الشريعة الإسلامية رؤية حضارية معاصرة مثلت فيها صناعة الفقه إحدى أدوات صنع الحضارة الإنسانية، من خلال تقديم التصورات الشرعية المناسبة لقضايا الحياة المعاصرة والمستجدات والنوازل، مع مراعاة البعد الأخلاقي في هذه القضايا وعدم إغفاله.
والإسلام ينظر إلى التطور في حياة الإنسان على أنه سنة كونية مقدرة من الله سبحانه وتعالى فإنسان الأمس ليس كإنسان اليوم وليس كإنسان الغد، وكذلك الحال بالنسبة للمجتمعات، فهناك متغيرات على الدوام، وتطور لا يتوقف، والدين الإسلامي يمد الإنسان بالمرجعية العقدية والقيمية والتشريعية اللازمة للتعامل مع هذا التطور، والتاريخ يشهد كيف تعامل الدين الإسلامي بالحث على العلم والعمل والتشجيع للفنون والآداب والمبتكرات العلمية، ومجالات العمارة الإسلامية وآثارها المادية تشهد على تعاطي الدين الإسلامي مع حياة الإنسان على الأرض وسعيه لتحقيق وسائل الراحة ورغد العيش له.
([1]) انظر: حاشية الإمام الرملي على أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/4) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
([2])أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (3592)، والترمذيُّ في كتاب الأحكام، باب ما جاءَ في القاضي كيف يقضي؟ (1327)، وأحمد في مسنده (22007) والدَّارمي في سننه (170)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 758) من طريق شُعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شُعبة عن أناسٍ من أهل حِمص من أصحاب مُعاذ بن جبل به.
([3]) أخرجه أحمد في مسند (22291) والطبراني في الكبير (7715) من حديث أبو أمامة رضي الله عنه.
([4]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين يسر (39).