أرشيف الفتاوى
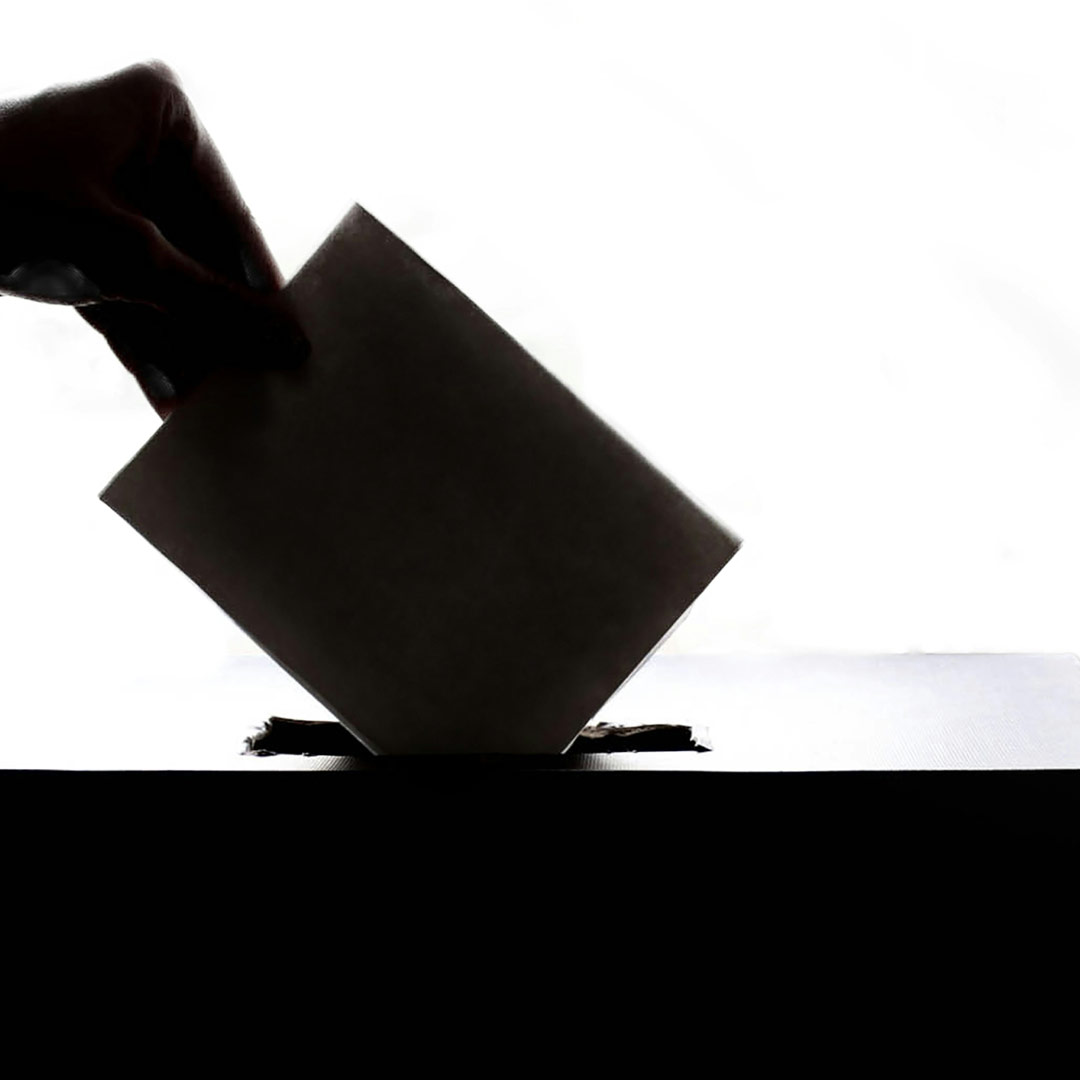

أنزل الله سبحانه وتعالى الدين هداية للناس من حيرتهم، وإرشادًا لهم إلى الحقائق العليا والأصول الكلية التي ينبغي أن تتنبه لها عقولهم، وأن تعيَها أفئدتهم وقلوبهم، فمنذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام وعلَّمه ما لم يكن يعلم من الأسماء، فتح له نافذة إلى إدراك حقائق الأشياء، وإلى الوصول إلى الحكمة والهدى والرشاد، والسعي في هذا الكون لمرضاة الله ووفق مراده، وما زالت تلك رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تزيل عن المبعوثين إليهم جهالات الأهواء وظلماتها، وتردهم إلى الفضائل والكمالات والمرادات الإلهية، وكل الشرائع ترسِّخ في مضامينها حقائق الدين الكبرى، وتتجلى فيها رؤية متكاملة للخالق والإنسان والوجود كله، تستوعب تلك الرؤية مفاهيم وجودية كمبدأ الإنسان ومصيره وغايته، وتميز بين الخير والشر، وتبين علاقة الخالق بالمخلوقين، والروابط بين الموجودات في هذا الكون، ليكون ذلك إطارًا جامعًا لتفاصيل هذا الدين وجزئياته.
يجيب الدين بهذا المفهوم السابق عن الأسئلة الوجودية الكبرى، وهو أمر تشترك فيه الأديان السماوية كلها، وبالتالي فهي تشترك في بناء نموذج معرفي يقوم على أصل الإيمان بالخالق، وعلى طبيعة وغاية وجود الإنسان ومركزيته في هذه الدنيا، وعلى التصديق بوجود حياة أخرى بعد الموت، والإيمان بالأمور الغيبية وإثبات موجودات لا تدرك بالوجود الحسي، وهذا الإطار العام خلق إنسانًا مؤمنًا، يدرك أن غايته في الدنيا هي العمل والسعي لإنفاذ المراد الإلهي، وأنه قد سخر له هذا الكون ليقوم فيه بواجب العمران، وأن سيادته في هذه الدنيا إنما هي أمانة ثقيلة حملها بمقتضى ما أعطي من العقل الإنساني المفكر، لا أنها سيادة على الكون تبيح له التصرف فيه كيف شاء.
لقد نشأت كثير من الفلسفات والمذاهب والأفكار التي حاولت الإجابة عن الأسئلة الوجودية التي تشغل الإنسان، وكانت كثير من تلك المحاولات تستند إلى العقل أو إلى الوجود الحسي المشاهد، بينما كان الفكر الديني يعتمد الوحي والكتب المنزلة في الجواب عن هذه التساؤلات، وهذا يمثل بلا شك فارقًا كبيرًا بين هذه المصادر في المعرفة والتلقي، من حيث طبيعتها ومصدريتها وموثوقيتها لدى المتلقي، وهذا مبني على طبيعة معتقداته وأفكاره وآرائه الدينية.
إن المؤمن لا يجد نفسه حائرًا أمام هذا النوع من الأسئلة؛ لأنه بإيمانه قد وسَّع دائرة المصادر التي يتلقى منها المعرفة، خصوصًا في الأمور الغيبية التي لا يستطيع أن يخضعها لقوانين التجربة والحس، أو لقواعد العقل المحضة، فيدفعه إيمانه ببصيرة العقل ونوره إلى التصديق بالأخبار المنزلة من عند الله، والتي تزيل حيرته وتدفع عنه الشكوك والأوهام، فيجد في الكتب المنزلة غاية الخلق، والحديث عن التوحيد وصفات الكمال الإلهية، وقضايا البعث والحشر والمعاد، والقيم الأخلاقية التي يجب عليه أن يلتزمها في حياته، ويجد نظامًا متكاملًا من التشريعات التي تربطه بهذه الحقائق، والمؤمن في كل ذلك يتلقى خطابًا إلهيًّا قد بلغ عنده أقصى درجات الموثوقية، وأسمى مراتب البيان، يحدد له المسار الذي يجب عليه أن يسلكه، ويفتح له آفاق هذا العالم الفسيح، بل يرقى به في الكمال الإنساني، حتى يخلصه من سجن المادة وينفذ به إلى فضاء الروح.
لم تكن الإجابات التي قدمتها كثير من المدارس الفلسفية هادية من تلك الحيرة التي يجدها الإنسان في نفسه أمام ذلك النوع من الأسئلة، خاصة إذا كانت تساؤلات تحاول أن تجد تفسيرًا للأفعال الإلهية، مثل البحث في قضية خلق الشر في العالم، ومحاولة البحث عن إجابة لتلك الأسئلة من خلال مصادر لا تستند إلى الوحي كالعقل المجرد أو الحس لن تكون إلا إجابة مضطربة لا تحقق للإنسان السكينة والاطمئنان، بينما نجد الجواب الديني يخبرنا عن الله سبحانه أنه ليس كمثله شيء، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا يسئل عما يفعل، وحينئذٍ فلا تتطلع النفس البشرية إلى تفسير ما هو خارج عن طاقتها وقدرتها؛ لأنها قد أقرَّت بالحكمة والقدرة المطلقة لله، ومع ذلك فإن هذا الجواب يكون مقترنًا بإبراز مظهر من مظاهر تلك الحكمة، كقوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35] وفي هذا المعنى كفاية للإنسان عن دعوى وجود العبث في الخلق، مصداقًا لقول الله جل جلاله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115] في إنكاره دعوى من لم يؤمن بالمعاد.
لقد سعى علماء التوحيد إلى ربط تلك العقائد الإيمانية المبثوثة في الكتاب المنزَّل وفي السنة المشرفة ببراهين العقول وأدلتها، وذلك لأنهم وجدوا أن الفلسفة قد تناولت تلك المباحث بمحض النظر العقلي دون هدى الشرع، فشرعوا في تأسيس هذا العلم على نظر العقل المؤيد بالنقل، كما قال السعد التفتازاني رحمه الله في شرح المقاصد: «اعلم أن للإنسان قوةً نظريةً كمالُها معرفةُ الحقائق كما هي، وعمليةً كمالُها القيامُ بالأمور على ما ينبغي؛ تحصيلًا لسعادة الدَّارَين وقد تطابقت الملَّةُ والفلسفةُ على الاعتناء بتكميل النُّفوس البشريَّة في القوَّتين، وتسهيل طريق الوصول إلى الغايتين، إلا أن نظر العقل يتبَعُ في الملَّة هُداه، وفي الفلسفة هَوَاه، وكما دَوَّنت حكماءُ الفلسفة الحكمةَ النظريَّة والعمليَّة إعانةً للعامَّة على تحصيلِ الكمالاتِ المتعلِّقة بالقوَّتَين، دَوَّنت عُظماء الملَّة وعلماء الأمَّة علمَ الكلامِ وعلمَ الشَّرائع والأحكام، فوقع الكلامُ للملَّة بإزاءِ الحكمة النظريَّة للفلسفة»([1]). وهذا العمل كان عملًا تجديديًّا يراعي الوسائل المعرفية التي انتشرت في ذلك الزمان، ويقوم بواجب الوقت في صياغة الإجابات الدينية على الأسئلة الكبرى في صورتها العقلية النظرية.
وفي القرنين الأخيرين اللذين كثرت فيهما الاكتشافات العلمية الحديثة، وأثبت المنهج التجريبي جدارته في العلوم التطبيقية، وفتح آفاقًا واسعة في دراسة الكون والإنسان، ظهر عدد من المذاهب الفكرية التي تدعوا إلى إعادة البحث في الأسئلة الوجودية الكبرى بهذا المنظار الجديد، وإلى وضع هذه القضايا والمسائل تحت حكم منهج المعرفة المتداول في العلوم التجريبية، وساعدهم على هذه الدعوى كثرة الاكتشافات الكونية التي حاولوا من خلالها وضع تفسيرات جديدة لنشأة الكون، ورفضوا كثيرًا من المفاهيم الدينية التي تتحدث عن بدء الخلق، أو عن الغاية والمصير، أو التي لا يمكن إثباتها بالمشاهدة الحسية، وهي أمور كثيرة من الغيبيات التي وردت في الكتب المنزلة، لا يتوصل إلى الإيمان بها إلا بالخبر الصادق.
لقد غاب عن هذه الدعوات مبدأ هام، وهو أن الكتب السماوية التي ذكرت فيها الحقائق الإيمانية ليست كتبًا علمية تعنى بذكر حقائق فيزيائية عن الكون مثلًا، ويمكن معارضتها بما وصل إليه العلم الحديث، وندخل بذلك في إشكالية جديدة تتعلق بالتناقض بين العلم والدين، وإنما مقصد الدين بيان الحقائق التي لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بأدواته المعرفية؛ لأنها سبقت وجوده أصلًا كبدأ الخليقة، أو لأنها غيب لا يمكن أن يحصله كالرجوع إلى الله سبحانه في الآخرة والمعاد، أو لأنها أمر خارج عنه وهو مأمور بتحصيله، كغاية الخلق في قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56 ] فالعبادة مطلوب إلهي لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بإخبار من الله، وهي كلها أمور وقضايا لا يمكن لمنهج بشري أن يحيط بها، ولا أن يستطيع الجواب عنها، لكن الدين يدعو الإنسان فيما سوى ذلك إلى النظر والتفكر، وإجراء المناهج العلمية فيما تعلقت به طاقته وقدرته من هذا الكون.
إن هذه المحاولة لاستعمال مناهج لا تستند إلى الدين في إجاباتها قد أثرت بشكل واضح على أحد أهم الأسئلة الكبرى، وهو السؤال الأخلاقي من حيث مصدرية الأخلاق، حيث لم يبق بعد استبعاد المصدر الديني إلا اعتبار العقل أو الحس، وكلاهما يؤدي إلى نسبية الأخلاق، وهو أمر مفسد للبشرية ومدمر لها، فالعقل لن يكون أمرًا معياريًّا يصلح أن يكون مرجعًا للأخلاق؛ إذ تتفاوت العقول في إدراكها لحسن الأشياء وقبحها، وأما الحس والتجربة اللذين تبناهما المذهب النفعي الذي يرى الخير المطلق في اللذة والشر المطلق في الألم فهو أشد نسبية من مذهب العقليين السابق؛ حيث لا يمكن ضبط مفهوم اللذة والألم لدى كل الأفراد، أو لدى مجموعهم، فيصير معنى الأخلاق في المذهبين معنًى فضفاضًا لا يمكن أن يكون مرجعًا للمكون الأخلاقي الذي هو أحد أهم مكونات الفعل الإنساني، وعدم معياريته وانضباطه هو منشأ الفوضى واختلال النظم العامة في الحياة الفردية والمجتمعية، وبهذين المذهبين تتحول الفلسفة من معنى طلب الحكمة والكمال الإنساني إلى معنى الاستسلام للغواية والشرور، وغياب البعد الأخلاقي الذي يحافظ على الفطرة الإنسانية.
إن العلاقة بين الدين وبين الأسئلة الوجودية هي علاقة حتمية لمن أراد أن يسلك سبيل الرشاد؛ حيث إننا بإزاء أسئلة عن المقاصد الكبرى التي لا يمكن أن يصل إليها علم أحد من العالمين إلا بمعونة من الخالق سبحانه وتعالى وإرشاد وهداية، ويبقى العقل إطارًا مرجعيًّا للإدراك والنظر والاستبصار، وأما التجربة والمشاهدة الحسية فلابد أن تظل فاعلة في تعميق فهم وإدراك الإنسان والكون والحياة، لتفسر الظواهر الطبيعية وخصائصها وأحوالها، لكنها لن تكون مجدية أبدًا في تفسير الفعل الإلهي عند من يسلم بوجود خالق فاعل مختار.